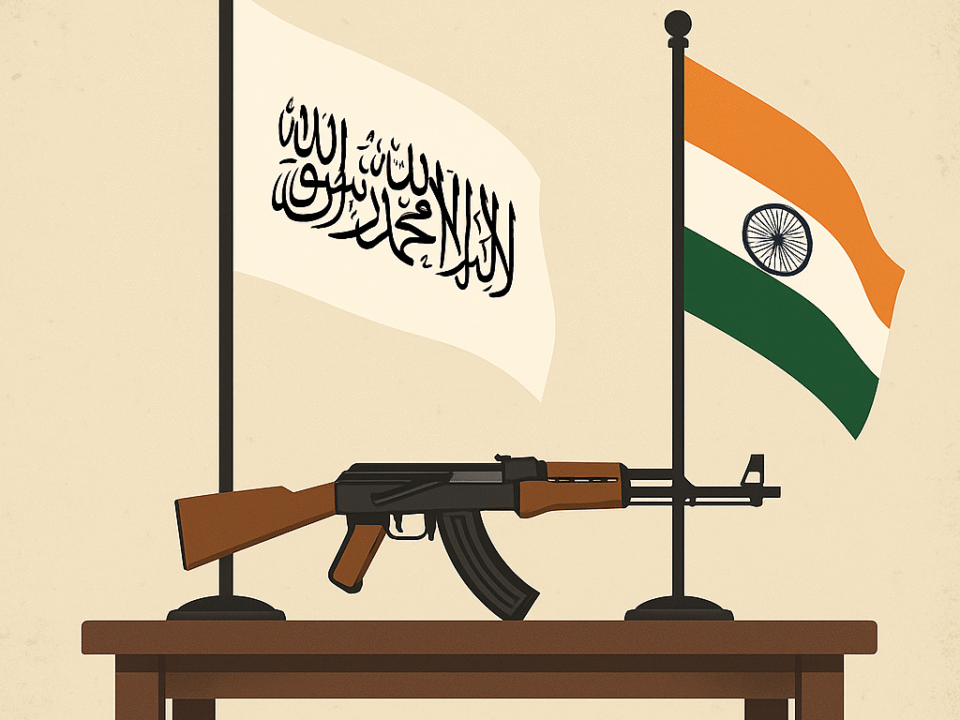مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة بعد موجة التطبيع الجديدة
2025-05-27
هل يمكن إصلاح الدولة من داخلها؟ تأملات في جدوى الإصلاح التدريجي
2025-05-31بقلم: منصة المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
1. مدخل تأملي
برأيي، لم يكن الصراع في السودان يومًا مجرد نزاع تقليدي بين العسكر والمدنيين، بل كان — ولا يزال — صراعًا عميقًا على من يملك شرعية تعريف الوطن، ومن يُسمح له بالنطق باسم “الحق” في الوعي الجمعي والسياسي. إنه صراع على المعنى قبل أن يكون على السلطة.
تأمّلي في المشهد السوداني يقودني إلى قناعة بأن السلاح وحده، على الرغم من رمزيته، لم يكن كافيًا لمنح الجيش الهيمنة الكاملة على الدولة والمجتمع. كانت هناك حاجة إلى “شرعية معنوية” تعطي غطاءً للهيمنة، وهذا ما لبّاه الخطاب الديني حين وظّفه العسكري بذكاء في كثير من المحطات، لا كقناعة أيديولوجية، بل كأداة لتحصين الحكم.
وهنا بالذات، لم يظهر تيار الإسلام السياسي في السودان بوصفه البديل الثوري أو الخصم الطبيعي للمؤسسة العسكرية، بل كـشريك ضمني في إنتاج “مشروعية السلطة”، يتقاطع معها تارة ويتكئ عليها تارة أخرى. هذا التيار، الذي رفع شعارات “الحق” و” الشريعة” و” التكليف الإسلامي”، لم يمانع أبدًا في أن تكون بندقية الجيش حارسًا لـ” مشروعه”، ولو على حساب مناداته بالعدالة والحرية.
لقد سلك الإسلاميون في السودان طريقًا مركّبًا: من المعارضة إلى التحالف، ومن التحالف إلى التماهي، ثم من التماهي إلى الإقصاء. وفي كل طور من هذه الأطوار، لم تكن البندقية غائبة، ولا المنبر صامتًا، بل كان كل منهما يُستخدم في لحظته المناسبة لفرض الرؤية أو تثبيت الحكم.
حتى حين ظنّ البعض أن الجنرال بات جزءًا من “المشروع الإسلامي”، فإن الحقيقة كانت أكثر تعقيدًا:
كان الجنرال أقرب إلى “البراغماتي الذي يستثمر في الخطاب الإسلامي”، لا إلى الحاكم المتدين المؤمن بـ” دولة العقيدة”.
وكانت الحركة الإسلامية في المقابل، مستعدة لتقديم التنازلات، بل وللتماهي مع الدولة الأمنية، مقابل استمرارها في مراكز النفوذ، حتى ولو من خلف الستار.
إن هذه العلاقة بين البندقية والمنبر في السودان لم تكن مجرد تحالف مصالح عابر، بل كانت — في مراحل عديدة — مشروعًا مشتركًا لإعادة تشكيل الدولة وفق مزيج من التديّن الوظيفي والعسكرة الرمزية. ومع ذلك، فإن هذا التحالف لم يصمد أمام التحولات الكبرى، بل تكسّر حين اصطدمت المصالح بالواقع، وتفكك حين ظهرت التناقضات بين منطق القوة ومنطق الدعوة، بين من يسعى للحكم باسم الله، ومن يحكم بالحديد والنار.
بهذا المعنى، فإن تجربة السودان تقدم لنا نموذجًا حيًا لفهم طبيعة العلاقة المركّبة بين المؤسسة العسكرية وتيار الإسلام السياسي في العالم العربي، وكيف يمكن لهذه العلاقة أن تتحول من شراكة وظيفية إلى صراع وجودي، كلما اختلّت موازين النفوذ أو تبدّلت أولويات الحكم.
2. من النميري[ii] إلى البشير[iii]: الطريق إلى أسلمة البندقية
حين ضاق جعفر نميري بالمشاريع اليسارية والقومية التي عجزت عن تحقيق الاستقرار والتنمية، التفت إلى التيار الإسلامي السياسي ممثلًا في حسن الترابي [iv]وجبهة الميثاق الإسلامي، ساعيًا لتجديد شرعيته الداخلية وبناء قاعدة جديدة بعد تفكك تحالفاته التقليدية. وهكذا، لم تكن مراجعة نميري لمواقفه الفكرية تحوّلًا نابعًا من قناعة دينية صرفه، بل كانت خطوة براغماتية لإنقاذ سلطته من السقوط.
من خلال تأملي، أرى أن المنعطف الأخطر كان حين تحوّل الجيش السوداني – لا كجهاز أمني فقط، بل كمؤسسة وطنية – إلى أداة تنفيذ مباشر لما عُرف بـ” قوانين سبتمبر” عام 1983[v]. هذه القوانين، التي حملت توقيع نميري لكنها استلهمت خطاب الترابي ورؤيته للشريعة، جعلت الدين غطاءً للحكم المطلق، واستخدمت الشريعة كسوط لإخضاع المجتمع، لا كمنظومة عدالة.
فبدل أن تكون مؤسسة القضاء مستقلة، أُعيد تشكيلها على أساس “الولاء العقائدي”، وتحوّل رجال الشرطة والجيش إلى منفذين لعقوبات الحدود، في مشهد جسّد الاندماج القسري بين السلطتين الزمنية والدينية.
لكن الذروة التي كرّست هذا التداخل الخطير بين “الدعوي” و” العسكري” جاءت، كما أقرأها، في انقلاب عام 1989، حين انقلب عمر البشير – بدعم مباشر ومُسبق التخطيط من الجبهة الإسلامية القومية بقيادة الترابي – على النظام الديمقراطي الوليد.
هنا، لم يعد الإسلام السياسي مجرّد حليف للجيش، بل أصبح جزءًا من بنيته الداخلية، يحرّك قراراته، ويتغلغل في مفاصله، ويصوغ خطابه التعبوي.
في ذلك الانقلاب، تلبّس الجنرال خطاب الداعية، ولم يعد صوت البندقية منفصلًا عن صوت المنبر، بل باتت الدولة السودانية تسير وفق عقيدة جديدة:
الجنرال يحكم لا باسم “الأمن”، بل باسم “الشريعة”، والشرطي لا يعتقل خصمه باسم النظام، بل باسم “الدين”، والمعركة ضد المعارضة لم تعد سياسية فقط، بل “جهادية”.
لقد شهدت السنوات الأولى لحكم البشير ما يمكن تسميته بـ” الأسلمة المؤسسية للدولة”، حيث أعيدت صياغة قوانين الخدمة المدنية والتعليم والإعلام والقضاء على أساس “الرؤية الإسلامية”، بتمكين كامل من كوادر الإسلام السياسي الذين انتقلوا من الهامش إلى صلب السلطة.
وبينما حافظ الجنرال على قبضته الحديدية، وفّر له التيار الإسلامي الغطاء الأخلاقي والشعبي، في مشهد تحالفٍ قلّ نظيره في العالم العربي.
غير أن هذا التلاقي لم يكن أبديًا، بل بدأ بالتصدّع حين اصطدمت حسابات السلطة بتناقضات الإيديولوجيا، خاصة بعد المفاصلة الكبرى بين البشير والترابي عام 1999. فقد اتضح حينها أن المشروع لم يكن واحدًا، وأن الجيش وإن حمل شعارات الإسلاميين، ظل في العمق حريصًا على مركزية القرار العسكري، ولو على حساب “المنبر”.
إن الطريق من النميري إلى البشير لم يكن فقط انتقالًا من “الانقلاب على اليسار” إلى “التحالف مع الإسلاميين”، بل كان أيضًا تحولًا في طبيعة الدولة السودانية ذاتها:
من دولة تبحث عن هوية وطنية جامعة، إلى دولة مؤدلجة تسير وفق تصور أيديولوجي إقصائي، تشكّلت فيه البندقية والمنبر كجناحين لحكم واحد… قبل أن يتكسّر أحد الجناحين على صخرة الواقع المعقّد.
3. الانقسام داخل البيت الواحد: الترابي يُقصى والبشير يحتكر الخطاب[vi]
برأيي، الوفاق الذي نشأ بين السلطة وتيار الإسلام السياسي في السودان لم يكن سوى زواج مصلحة مؤقت، لا تحالفًا قائمًا على رؤية استراتيجية متكاملة. فالطرفان — الجيش والجبهة الإسلامية القومية — لم يتشاركا مشروعًا وطنيًا بقدر ما تبادلا الأدوار لمواجهة خصومهما، ثم تصادما عندما تعارضت مصالح النفوذ والقرار.
لقد أدرك البشير، بعد سنوات قليلة من حكمه، أن الشيخ حسن الترابي ليس مجرد مفكر إسلامي أو منظر سياسي، بل رجل دولة يسعى للتأثير في مفاصل القرار، بل ربما تجاوزه. وقد كان من الطبيعي — بل من المحتوم — أن تنفجر هذه الثنائية المتوترة بين “الحاكم العسكري” و”العقل الحركي”، خصوصًا بعد أن بدأت تحركات الترابي في البرلمان واتصالاته الإقليمية تثير قلق القيادة الأمنية.
ومن هنا جاءت المفاصلة الكبرى عام 1999، حين أُقصي الترابي عن السلطة، واعتُقل لاحقًا، ثم فُكّك جناحه السياسي والتنظيمي. لكن المفارقة — وهنا مكمن التحول — أن البشير لم يقطع صلته بالإسلام السياسي، بل أعاد هندسته بما يخدم احتكار السلطة والخطاب الديني معًا.
فبدل أن يكون الإسلاميون شركاء في الحكم، أُعيد تشكيلهم كجناح تابع، منزوع القرار، يعمل كـ”واجهة أخلاقية” لا كفاعل سياسي مستقل.
من خلال تحليلي، لا يبدو أن البشير تخلّى عن تيار الإسلام السياسي، بل جرّده من أدوات التأثير الحقيقي، واحتفظ له بمكان في المشهد، شرط أن يظل هذا المكان تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.
وبذلك، تحوّل الخطاب الإسلامي من مشروع تغييري إلى أداة تعبوية تخدم السلطان، وصار رجال الحركة الإسلامية مجرّد موظفين في جهاز الدولة، يتحدثون باسم الدين، لكن بما لا يخرج عن هوامش البندقية.
أصبح الإسلام السياسي في عهد البشير دينًا بلا دعوة، وحركة بلا مشروع.
سُحبت منه الروح الرسالية، واكتفى بلغة الشعارات، و”التمكين الإداري”، والتعيينات في مواقع الدولة، بينما فرّغ من أي قدرة على النقد أو التجديد.
وهكذا، تحوّل من قوة تعبّر عن هوية اجتماعية أو رؤية إصلاحية، إلى مكوّن من مكونات السلطة الأمنية، يُستخدم عند الحاجة، ويُهمّش عند الخطر.
أما الجيش، فقد ظلّ هو السيد الحقيقي للمشهد، يراقب الجميع، ويضبط الإيقاع، ويُعيد ترتيب الأوراق كلما أحسّ بأن أحدًا يحاول تجاوز الخطوط.
وبات الإسلام السياسي مسندًا طيّعًا، يلعب دور “الوليّ التابع”، يبارك القرارات، ويُشرعنها دينيًا، دون أن يمتلك حق النقاش الجاد، أو حتى الحق في صياغة أولويات الحكم.
وهنا، يكمن الفارق الجوهري:
فقد بدأ الإسلاميون في السودان كحركة طامحة لحكم البلاد باسم “الشريعة”، ثم انتهوا إلى مجرد جهاز يزين وجه السلطة بشعارات دينية، فيما تُدار الدولة بقرارات الجنرال وحده.
4. لحظة الانفجار: الثورة تُحاصر الجميع[vii]
حين خرج الشعب السوداني إلى الشوارع في ديسمبر 2018، لم يكن غضبه موجّهًا إلى رأس النظام فقط، بل إلى كل منظومة الحكم التي تشكّلت خلال ثلاثة عقود من التماهي بين العسكر والدين، بين الشعار والبطش، بين الدعوة والدبابة.
لقد خرج السودانيون ضد البشير، نعم، لكنهم خرجوا أيضًا ضد ما مثّله البشير: نظامًا يختبئ خلف شعارات “التمكين”، ويفرض سطوته باسم “الشريعة”، بينما يغرق في الفساد والتضييق والحروب.
من خلال تتبعي للحظة المفصلية، بدا لي أن الجيش، وقد شعر بأن سفينة السلطة تغرق، قرأ التحوّلات بذكاء تكتيكي. لم يتمسك بالبشير للنهاية، ولم يصطدم بالشارع صدامًا شاملًا، بل قرر، كما فعلت جيوش عربية أخرى، أن يُسقط رأس النظام لحماية الجسد.
وفي مشهد يختزل كثيرًا من الدروس، انقلب الجيش على شريكه، واعتقل البشير، وبدأ في إعادة تموضعه كمؤسسة وطنية “تحترم إرادة الشعب”، حتى ولو كانت تلك الإرادة تهدد نفوذه. لكن، ما سقط يومها لم يكن البشير فقط.
سقط وهمٌ عميق تشكّل لعقود: أن تيار الإسلام السياسي هو الحليف الذي لا غنى عنه في الحكم، وأنه قادر على ضبط الشارع من خلال الخطاب الديني، أو تخدير الناس باسم الجهاد والدولة الإسلامية.
فقد ظهرت الحقيقة على الأرض: الجيل الجديد لم يعد يصدّق تلك السرديات، ولم يعد يرى في العمائم ولا في الخطب وسيلة لحماية لقمة العيش أو كرامة الإنسان.
لقد حوصِر الجميع. الجيش وُضع أمام خيارين: الانحياز الكامل للشعب أو القطيعة معه. والإسلاميون وجدوا أنفسهم، للمرة الأولى منذ انقلاب 1989، خارج دائرة القرار، عاجزين عن التأثير في الشارع، أو حتى استعادة خطابهم القديم بجدية.
ومن هنا، يبرز السؤال الجوهري: هل انتهى تيار الإسلام السياسي في السودان؟ أم أنه فقط انسحب، متخفيًا، في انتظار فرصة جديدة؟
تحليلي يميل إلى أن التيار لم ينتهِ كمجموعة أفكار أو كشبكة تنظيمات، لكنه خسر الكثير من شرعيته الرمزية والشعبية، وأصبح بحاجة إلى مراجعة عميقة.
لقد فشل في أن يُقدّم مشروعًا حقيقيًا لإدارة الدولة، كما فشل في أن يُحدث فرقًا أخلاقيًا حين حكم.
وربما الأهم من ذلك، أنه فشل في البقاء خارج منطق السلطة حين فسدَت، فصار شريكًا في كل ما جرى.
ومع ذلك، فإن تجارب التاريخ تقول إن الإسلاميين لا يموتون بانتهاء تحالف أو سقوط نظام، بل يُعيدون التموضع داخل البنى الاجتماعية، ويُجدّدون لغتهم، ثم يعودون، لا كقوة تغيير، بل أحيانًا كقوة تعايش ذكي، أو حتى كمجرد معارضات براغماتية تنتظر “اللحظة المناسبة”.
لكن ما تغيّر بعد الثورة، هو أن الوعي الشعبي بات أكثر حذرًا، وأكثر رفضًا لأي تكرار، سواء بلباس ديني أو ببدلة عسكرية. لقد فتحت الثورة نافذة جديدة للوعي، يصعب إغلاقها بخطاب قديم.
5. ما بعد الثورة: صمت لا يعني قطيعة[viii]
من خلال قراءتي الدقيقة للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط البشير، بدا المشهد السوداني وكأنه دخل في حالة من التعليق الرمادي.
الجيش وقف في المنتصف، مترددًا بين الانحياز الكامل للمطالب الثورية، وبين الحفاظ على ما تبقّى له من نفوذ وهيمنة؛ وتيار الإسلام السياسي، الذي لطالما ملأ الساحة بالخطاب والدعوة، انسحب فجأة من المشهد،
أو بالأحرى أُجبر على التواري… مؤقتًا.
لكن، وكما علّمتنا تجارب ما بعد الثورات في دول عدّة، الغياب الظاهري لا يعني القطيعة الحقيقية.
ففي السياسة، كما في المسرح، ما يُعرض على الخشبة لا يكشف كل ما يدور خلف الستار.
فتيار الإسلام السياسي في السودان – بحسب تتبعي لخطاباته وتكتيكاته – لم يختفِ، بل أعاد ترتيب صفوفه بهدوء، واستثمر حالة السيولة السياسية ليحافظ على شبكاته داخل المجتمع، بل وحتى داخل بعض المؤسسات العميقة.
تجنّب الصدام، وخفّف من خطابه التعبوي، وترك المجال لقوى أخرى لتتقدّم، في انتظار لحظة تعب الشارع أو ارتباك الخصوم.
أما المؤسسة العسكرية، فقد تبنّت استراتيجية الترقّب والمناورة، فبدلًا من إعلان القطيعة مع الإسلاميين، أو التحالف معهم مجددًا، اختارت التموضع في “المنطقة الرمادية” — لا عدو ولا حليف.
فالعسكر، كما أقرأهم، لا يرون في الإسلام السياسي مشروعًا حيويًا بحد ذاته، لكنهم يرونه أداة ممكنة ضمن معادلة القوة والتفاوض، يمكن استخدامها حين تشتد الضغوط، أو التلويح بها لإرباك الخصوم المدنيين.
لقد بدا لي أن بعض العسكر – كما توحي مواقف متعددة في تلك المرحلة – أعادوا تقييم التحالفات القديمة، ليس بدافع أيديولوجي، بل وفق حسابات النفوذ والتكتيك.
فهم يدركون أن الثورات لا تبقى مشتعلة إلى الأبد، وأن حالة “الإقصاء الكامل” لا تدوم، وأن “الترويض” أحيانًا أكثر جدوى من “المجابهة”.
وما يُثبت ذلك – بحسب ما لاحظت مرارًا – هو أن الصفقات السياسية الحقيقية لا تُعقد في المؤتمرات الصحفية، ولا تُعلن عبر البيانات، بل تُصاغ خلف الأبواب المغلقة، حيث يتم تقاسم النفوذ، وتدوير الأدوات، وصناعة التوافقات الهشّة.
هنا، في هذه الغرف الجانبية، حيث يغيب الإعلام ويعلو منطق البراغماتية، قد يكون الإسلاميون جزءًا من حسابات المستقبل، حتى إن لم يكونوا جزءًا من مشهد الحاضر.
وقد يكون الجيش قد احتفظ بخيوط العلاقة القديمة، لا حبًا، بل لأن السياسة في السودان – كما في غيره – لا تعرف العداوات الدائمة ولا التحالفات الأبدية.
إن صمت الإسلاميين بعد الثورة، لا يعني قطيعة، بل يُحتمل أنه صمت تكتيكي. وإن تردد العسكر في حسم الموقف من هذا التيار، لا يُفسَّر فقط بالخشية من الماضي، بل أيضًا بحسابات المستقبل التي لا تزال قيد التشكل.
6. ما الذي تعلّمه الجيش… وما الذي لم يتعلمه الإسلاميون؟
بعد أكثر من ثلاثة عقود من التجربة المشتركة، والصعود والسقوط، والانقلابات والمفاصلات، تقف المؤسسة العسكرية السودانية وتيار الإسلام السياسي أمام مشهد متغيّر، لا يشبه ما بدأوا فيه.
لكن المفارقة اللافتة، من خلال تحليلي، أن الجيش تعلّم من التجربة… بينما الإسلاميين لم يتعلّموا بما يكفي.
الجيش السوداني، وإن كان قد انخرط في مشروعات الحكم وأُتّهم بالاستبداد، إلا أنه – بمرور الزمن – طوّر حسًا براغماتيًا عاليًا في التعامل مع التحولات السياسية.
أصبح يدرك أن التمويه، وإعادة التموضع، وتقديم تنازلات شكلية، قد تكون أدوات لحماية سلطته، أو على الأقل الحد من خسائره.
فقد عرف متى يتخلّى عن الحلفاء، ومتى يُعيد تدويرهم، ومتى ينكفئ ومتى يتقدّم.
بل صار يتقن لعبة “إدارة الواجهة المدنية”، و” تمكين الظل العسكري”، وهي مهارة لم تتقنها أغلب التيارات السياسية الأخرى.
في المقابل، تيار الإسلام السياسي – وعلى رأسه الكوادر التي حكمت مع البشير – أخفق في تطوير أدواته السياسية بعد الثورة. ظل أسيرًا لخطابه القديم، ومرجعياته الثابتة، وحنينه للماضي.
لم يُعد قراءة المجتمع، ولم يُحدث قطيعة مع تجربة الفساد والاستبداد، ولم يقدّم مراجعة جادة تستحق الإصغاء.
ظل يعيش على رصيدٍ أخلاقي أُنهك، وشبكات تنظيمية تآكلت، دون أن يُنتج خطابًا جديدًا يقنع الأجيال الصاعدة.
في الحقيقة، ما لم يتعلّمه الإسلاميون في السودان – وربما في غيره من الدول – هو أن السلطة تغيّر جوهر الحركة، وأن الحكم باسم الدين يتطلب أخلاقًا مضاعفة، لا شعارات مضاعفة.
لم يدركوا أن التمكين بلا محاسبة يولّد استبدادًا مضاعفًا، وأن التحالف مع الجنرال له كلفة، لا تعوضها “النية الحسنة” ولا “المرجعية الشرعية”.
أما الجيش، فقد أدرك أنه لا يحتاج إلى شريك أيديولوجي ثابت، بل إلى أوراق تفاوض متعددة، وأن الإسلاميين مجرد ورقة ضمن رزمة أدوات النفوذ، يُمكن استخدامها أو إحراقها وفقًا للظرف.
بهذا المعنى، لا يبدو أن العلاقة بين البندقية والمنبر في السودان ستعود كما كانت، لكن لا يمكن استبعاد تكرارها بصيغ جديدة، إن لم يتعلّم الطرفان الدرس الأهم:
أن الشرعية في القرن الحادي والعشرين لا تُمنح بالسلاح، ولا تُشترى بالشعار… بل تُنتزع من وعي الناس، ورضاهم، وثقتهم.
٧. انقلاب 2021: عودة “الهوية” من نافذة الجيش[ix]
لم يكن انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 مجرد خطوة لقطع المسار الديمقراطي أو إنهاء الشراكة مع القوى المدنية، بل – كما أقرأه – كان عودة منظمة إلى أدوات الخطاب القديمة التي لطالما استخدمت لتثبيت الحكم وتبرير السيطرة.
وبينما تغيّر الفاعلون، فإن اللغة التي أعيد تفعيلها كانت مألوفة جدًا: “الشرعية”، “الثوابت الوطنية”، “قيم المجتمع”، “حماية الدين والدولة” … مفردات نعرفها من أدبيات التيار الإسلامي السياسي، لا من أدبيات العسكريين.
لكن هنا تكمن المفارقة: لم يظهر تيار الإسلام السياسي في الصورة بشكل مباشر، لم يبارك الانقلاب علنًا، ولم يتصدر المشهد كما كان يفعل في السابق، بل بدا كما لو أنه ما زال في موقع المراقب.
إلا أن خطابه ظهر بقوة، ولغته تسللت، ونَفَسَه عاد يُسمع في تبريرات العسكر ومرافعات الإعلام الرسمي وشعارات بعض التظاهرات المصنوعة.
برأيي، لم يكن ذلك مجرد تقاطع لغوي عابر، بل كان استدعاءًا مدروسًا للهوية الدينية بوصفها غطاء سياسيًا، هدفه تأطير الانقلاب في صورة “تصحيح المسار الأخلاقي والوطني”، لا كعودة إلى حكم العسكر.
ومن خلال تتبعي لتفاعلات ما بعد الانقلاب، تبيّن أن المؤسسة العسكرية أعادت توظيف ورقة الهوية الإسلامية لا بهدف إعادة المشروع الإسلامي القديم كما هو، بل لتأمين شرعية جديدة تتجاوز السردية الثورية التي طالما تحدّت سلطتها بعد 2019.
ففي واقع ما بعد الثورة، لم تعد القوة وحدها كافية، بل بات من الضروري استدعاء “رموز المعنى” في المجتمع… والخطاب الديني يظل أقواها.
لقد أعاد انقلاب 2021 “الهوية” إلى الواجهة، ولكن بصورة مشوشة ومسيّسة أكثر من أي وقت مضى.
فهي ليست دعوة إلى تقوى، ولا مشروعًا أخلاقيًا واضح المعالم، بل شعارًا وظيفيًا يُرفع حين تشتد الحاجة، ويُسكت عنه حين تهدأ العاصفة.
وفي هذا السياق، فإن غياب الإسلاميين عن المشهد لا يعني بالضرورة غياب تأثيرهم.
فلعلهم أدركوا أن المرحلة تتطلب صمتًا تكتيكيًا، وترك المساحة للجيش كي يتحمّل العبء الظاهري،
فيما هم يُعيدون التموضع داخل المشهد الأمني والدعوي والتشريعي بهدوء، دون ضجيج الشعار.
إن ما حدث في 2021 يمكن اعتباره لحظة تَشابُه بين الانقلابات القديمة والجديدة في السودان، لكنه في ذات الوقت لحظة تعبير عن قدرة خطاب الإسلام السياسي على النجاة من السقوط الشكلي، والعودة كطيفٍ يحوم فوق مؤسسات الدولة، حتى دون تنظيم ظاهر.
وهكذا، نكون أمام نموذج يعكس توظيف الهوية الدينية من جديد، لا بوصفها قناعة نابعة من المجتمع، بل أداةً في يد العسكري، وساترًا في وجه الثورة.
٨. الحرب الأخيرة: البندقية تشتعل… والهوية تُستدعى من جديد
حين اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، بدا المشهد وكأنه انزلاق جديد نحو الفوضى، لكن – ومن خلال متابعتي الدقيقة – كانت تلك اللحظة أكثر من مجرد نزاع مسلح على السلطة.
لقد كانت أيضًا، وربما على نحو غير ظاهر، فرصة ذهبية لإعادة إدخال تيار الإسلام السياسي إلى معادلة “الشرعية الوطنية” من باب الأزمة.
ففي زمن الحرب، يتراجع الخطاب المدني، ويتقدّم الخطاب الأمني والهوياتي. وفي هذه اللحظة، لم يظهر الإسلاميون بصيغة القوة كما اعتادوا في التسعينيات، بل ظهروا بصيغة “المنقذ المحتمل”؛ من يملك الشرعية الدينية، والخبرة السياسية، وشبكة التأييد التي لا تزال حيّة في بعض المفاصل.
لقد فهم الإسلاميون أن زمن السيطرة الكاملة قد ولى، فتبنوا خطابًا أكثر تواضعًا، وقدموا أنفسهم كشركاء جاهزين وقت الحاجة، لا كمنافسين مباشرين.
ولعلهم أدركوا أن الحرب أوجدت فراغًا في الخطاب، وفي صياغة المعنى الوطني، يمكنهم أن يملأوه، ليس عبر السيطرة، بل عبر التسلل الرمزي إلى المجال السياسي والإعلامي والدعوي.
في المقابل، لم يُبدِ الجيش – كما بدا لي – أي موقف عدائي صريح تجاههم.
بل على العكس، برزت مؤشرات على أن بعض قادة المؤسسة العسكرية يرون في الإسلاميين ورقة يمكن الاستفادة منها في معركة طويلة ومعقدة مع الدعم السريع، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بتأطير الصراع بعبارات “الوطنية”، و” الشرعية”، و” مواجهة التمرد”.
ففي زمن الحرب، تعود الحاجة إلى سرديات كبرى… والدين – كما يعلم الجميع – أحد أقوى هذه السرديات.
وهنا يأتي دور الإسلاميين، الذين يملكون جهازًا مفاهيميًا جاهزًا، وقابلًا للتفعيل، وقد سبق توظيفه في مراحل مماثلة.
التقارير الغربية، ومنها ما نشرته وكالة رويترز[x]، تُلمّح بوضوح إلى وجود يد خفية للإسلاميين في توجيه دفة الصراع، أو على الأقل في محاولة التأثير على اتجاهات القرار داخل الجيش.
وبحسب تلك المصادر، فإن التيار الإسلامي لا يزال حاضرًا في الغرف الخلفية، ويعرف متى يتقدّم ومتى ينسحب، وكيف يفاوض وكيف يهادن.
وبالتالي، فالصورة التي ترتسم ليست لتيار مهزوم أو خارج من التاريخ، بل لقوة سياسية تتحين الفرص، وتتقن لعبة الكمون والظهور، وتعرف أن زمن الساحات انتهى، لكن زمن الكواليس لا يزال مفتوحًا.
وبينما تُستعر البندقية في ميادين الخرطوم ودارفور، تُستدعى الهوية مرة أخرى، لا كهوية جامعة، بل كسلاح في معركة الشرعية… ومع هذا السلاح، يعود الإسلاميون إلى الواجهة، لا كسلطة، بل كإمكانية قابلة للتفعيل في كل لحظة ضعف أو فوضى.
٩. توصيات: نحو جيش وطني يحمي الجميع
إن التجربة السودانية، كما عرضناها في هذا المقال، تكشف عن هشاشة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وتيار الإسلام السياسي، وعن خطورة التداخل بين الدين والبندقية، عندما يُستخدم الخطاب الديني لتسويغ الاستبداد، أو يُستثمر الجيش لحماية مشاريع أيديولوجية ضيقة.
ولأجل مستقبلٍ أكثر استقرارًا، وأكثر عدالةً، وأكثر وطنية، فإننا نوصي بما يلي:
• بناء جيش سوداني موحد، قائم على العقيدة الوطنية والمهنية، لا على الولاء الحزبي أو الأيديولوجي.
الانقسامات التي طالت بنية الجيش السوداني، والتجاذبات السياسية التي أثّرت على قراراته، أضعفت هيبته ووحدته. المطلوب اليوم هو جيش بعقيدة جمهورية، ينتمي للوطن وحده، ويعلو على الحسابات الفئوية.
ويكون انتسابه قائمًا على الكفاءة والانضباط، لا على “الولاء التنظيمي” أو “الخلفية العقائدية”. فالدولة لا تُبنى بجيوش متنازعة، بل بمؤسسة موحّدة تحمي الجميع.
• تحصين المؤسسة العسكرية من التوظيف الديني والسياسي، مع احترام الهوية الثقافية والدينية للشعب السوداني.
السودان بلد متنوع الهوية، عميق التدين، غني بالتعدد الثقافي. وليس من مصلحة أحد أن تتحوّل المؤسسة العسكرية إلى ذراعٍ لإحدى الرؤى الدينية أو الأيديولوجية.
ما نحتاجه هو مؤسسة محايدة سياسيًا، ومحترِمة للهُوية دون أن تُوظفها، ترى في نفسها حامية للجميع، لا لطرف دون آخر. فالتدين الشعبي لا يحتاج إلى عسكرة، بل إلى حرية وعدالة تحفظ كرامة الإنسان.
• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن الرقابة المدنية عليها في إطار دولة قانون.
الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا يكتمل دون إصلاح جذري في العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية.
نوصي بوضع آليات رقابية مستقلة، وتشريعات دستورية واضحة، تُلزم الجيش بالخضوع للسلطة المنتخبة، وتضمن عدم تكرار التدخلات الانقلابية أو التحالفات الخفية مع القوى السياسية.
• تجريم التداخل بين الخطاب الديني والسلاح، وتجفيف منابع التمكين الأيديولوجي داخل الجيش.
ينبغي على الدولة أن تضع حدًا واضحًا بين ما هو عَقَدي وما هو أمني، وأن تجرّم أي محاولة لاستغلال العقيدة الدينية لتبرير العنف أو الاستبداد. إن التداخل بين المساجد والثكنات، والخطبة والبندقية، هو خطر وجودي يهدد وحدة السودان، ويُفرّغ الدين من مضمونه الروحي، ويجعل السلاح أداة احتكار باسم السماء.
لا بد من إعادة ضبط هذا المسار عبر قوانين حازمة، ومحاسبة شفافة، وسياسات تجفيف حقيقية لمراكز التمكين العقائدي داخل المؤسسة الأمنية.
• تعزيز دور التعليم والإعلام في ترسيخ مفاهيم الجيش الجمهوري لا الفصائلي، والولاء للوطن لا للجماعة.
المعركة ليست فقط في الثكنات، بل في العقول. ولا يمكن بناء جيش وطني دون إعادة إنتاج الوعي العام، من خلال المناهج التعليمية، ومنصات الإعلام، والمساحات الحوارية الحرة.
ينبغي أن يُربّى الجيل القادم على أن الجيش هو مؤسسة وطنية، لا أداة بيد جماعة، ولا حصنًا لأيديولوجيا، بل ضامنٌ لحماية الحدود والحقوق والحريات.
ولكيلا تتكرر تجربة السودان المؤلمة، لا بد من فصلٍ حقيقي بين منطق البندقية ومنطق المنبر، وبناء مؤسسة عسكرية جمهورية تحمي الدستور، وتحترم التنوع، وتُحجِم أي محاولة لاستخدام الدين كسلاح.
فالأوطان لا تبنى بالتحالفات المؤقتة، بل بالمبادئ الراسخة… والولاء للشعب، لا للحزب.
٩. خاتمة: من يحتكر الله في معسكره… يخسر الجميع
برأيي المتواضع، لم يتحرر الجيش السوداني بعد من تأثير تيار الإسلام السياسي، ولا تحرر هذا التيار من الحنين العميق لمظلّة السلطة.
كلا الطرفين ما زال يراوح في منطقة رمادية: الجيش يستخدم الدين حين يحتاجه، ويتبرأ منه حين يحرجه؛ والإسلاميون ما زالوا يتقنون التمويه، منتظرين نافذة جديدة للدخول، حتى ولو من شقوق الخراب.
لكن المشكلة ليست فقط في هذا التواطؤ أو ذاك التداخل، بل فيما هو أعمق:
في استدعاء اسم الله ليُعلَّق على سلاح، أو ليرفع فوق دبابة، أو ليُزيّن شعارات نظام قمعي.
ففي كل مرة يُزج فيها بالدين في خندق سياسي أو عسكري، يخسر الوطن… وتخسر الفكرة، وتُشوَّه العقيدة، ويُستثمر المقدس في صراعات دنيوية لا تليق به.
لقد خسر السودان الكثير حين تحوّلت “الهوية الإسلامية” من قيمة جامعة إلى أداة إقصاء.
خسر حين بات الخطاب الديني يُبرر الفساد، ويُغطي القمع، ويُهاجم المطالبين بالحرية وكأنهم خصوم لله، لا شركاء في الوطن.
وبرأيي، السودان لا يحتاج إلى جيش بصبغة دينية، ولا إلى دعوة تمشي تحت مظلّة السلطة.
بل يحتاج إلى وطن تحكمه عقول لا شعارات، ومؤسسات لا منابر، ودولة ترفع القانون لا الخطبة، وتُقدّم الكفاءة لا الولاء الحزبي أو العقائدي.
السودان بحاجة إلى مصالحة وطنية، لا تتم عبر محاصصة بين الجنرال والداعية، بل عبر إعادة تعريف دور الجيش، وموقع الدين، ومفهوم الدولة ذاتها.
نعم، يمكن للدين أن يكون مصدرًا للقيم، ورافعة للعدالة، ومحرّكًا للإصلاح…
لكنه يفقد كل ذلك حين يُختزل في تحالف سلطوي، أو يُستخدم كدرع لحاكم لا يُحاسب.
أما الجيش، فلا يكون وطنيًا حقًا إلا إذا رفض أن يكون أداة لأحد.
فهو إما جيش للجمهورية… أو مجرد فصيل متورّط في لعبة النفوذ.
وفي النهاية، من يحتكر الله في معسكره… لا يربح المعركة،
بل يخسر الوطن… ويخسر نفسه… ويخسر الله
فبين البندقية والمنبر… سقطت الدولة. فهل نعيدها؟
المراجع والهوامش:
[i] في العالم العربي والإسلامي، تشكّلت العلاقة بين الجيوش وتيار الإسلام السياسي ضمن سياقات متقلبة، حيث تصارع الطرفان على شرعية تمثيل الدولة والمجتمع. ونحن في هذه السلسلة من المقالات، نسلّط الضوء على نماذج مختارة من دول المنطقة، لفهم كيف تحالفت الجيوش مع تيار الإسلام السياسي حينًا، ودخلت في صدام مفتوح معه حينًا آخر، بحسب تغيّر موازين السلطة والهوية.
[ii] جعفر نميري رئيس السودان من 1969 إلى 1985، وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري وتقلّب بين اليسار والقومية والإسلام السياسي. اشتهر بتطبيق “قوانين سبتمبر” وتحالفه مع الترابي قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية
[iii] عمر حسن البشير هو رئيس السودان الأسبق، تولّى الحكم بانقلاب عسكري عام 1989 بدعم من تيار الإسلام السياسي، وحكم البلاد ثلاثين عامًا شهدت استبدادًا وحروبًا داخلية وعزلة دولية، قبل أن تطيح به ثورة شعبية عام 2019.
[iv] حسن الترابي (1932–2016) هو مفكر وسياسي سوداني وزعيم بارز في تيار الإسلام السياسي، لعب دورًا محوريًا في التخطيط لانقلاب 1989 وتحالف الجبهة الإسلامية مع الجيش، قبل أن يتحول إلى معارض بعد انقسامه مع البشير عام 1999.
[v] قوانين سبتمبر هي تشريعات أعلنها جعفر نميري عام 1983 بتأثير من تيار الإسلام السياسي، وفرضت تطبيق الحدود والتفسيرات الدينية في النظام القضائي، مما أسهم في إشعال الحرب الأهلية الثانية وتعميق الانقسام الوطني.
[vi] المحبوب عبد السلام، الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء… خيوط الظلام، (دبي: دار مدارك للنشر، 2010)، صـ 145–150.
[vii] راشد عوض، “ما وراء الثورة السودانية”، إندبندنت عربية، 3 فبراير 2023،
https://www.independentarabia.com/node/397681
[viii] مجموعة الأزمات الدولية، حماية الثورة السودانية، التقرير الإفريقي رقم 281، 21 أكتوبر 2019،
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/281-safeguarding-sudans-revolution
[ix] في 25 أكتوبر 2021، نفّذ الفريق عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان، وأوقف مسار التحول الديمقراطي. برّر البرهان تحركه بـ” تصحيح المسار”، بينما اعتبرته القوى المدنية انقلابًا صريحًا أعاد الجيش للواجهة. رأى محللون أن الانقلاب وفّر فرصة لإعادة تموضع تيار الإسلام السياسي، رغم غيابه العلني بعد الثورة.
[x] رويترز، “الإسلاميون يلوّحون بيد خفية في صراع السودان، بحسب مصادر عسكرية”، 28 يونيو 2023،
https://www.reuters.com/world/africa/islamists-wield-hidden-hand-sudan-conflict-military-sources-say-2023-06-28