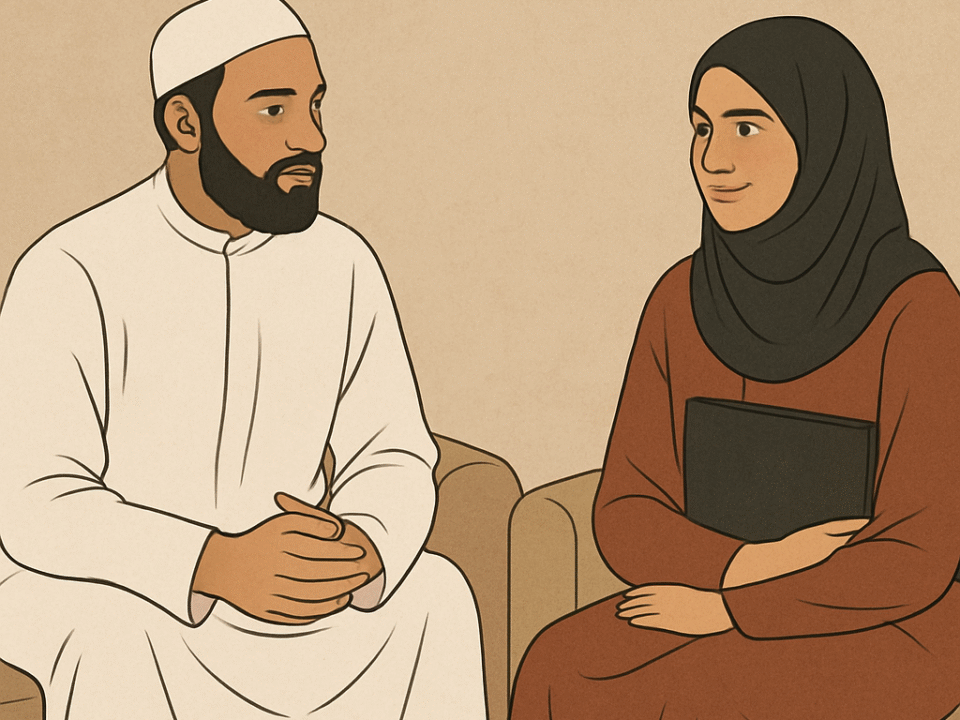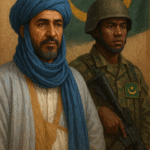
موريتانيا والتيارات الإسلامية: من إدارة التهديد الجهادي إلى ضبط تيار الإسلام السياسي
2025-06-01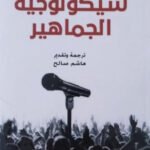
عصر الجماهير: قراءة تحليلية في سيكولوجيتها من منظور غوستاف لوبون
2025-06-09بقلم: منصة المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
مقدمة
لم يعد صعود تيار الإسلام السياسي في العالم العربي موضوعًا للنقاش النظري، بل أصبح واقعًا اختبرته الشعوب والدول بمراحل متباينة من التمكين والمشاركة والتراجع. فقد وصل التيار إلى السلطة في أكثر من بلد، وخاض تجارب حكم متنوّعة، ثم انسحب أو أُقصي أو تآكل نفوذه تدريجيًا.
غير أن المسار لم يكن واحدًا، ولا النتائج حتمية. ففي كل تجربة، لعبت السياقات الداخلية، والخيارات الفكرية والسياسية، والتحالفات المرحلية دورًا حاسمًا في تحديد المصير.
ومن خلال تحليل ست تجارب رئيسية في: السودان، مصر، تونس، المغرب، اليمن، والأردن، يتّضح أن التحدي الأكبر الذي واجهه الإسلام السياسي لم يكن دائمًا في خصومه أو في الضغوط الخارجية، بل في قدرته الذاتية على التأقلم، وإعادة تعريف دوره في ظل الدولة الحديثة.
السودان: من مشروع إسلامي إلى حكم سلطوي [1]
في السودان، لا يمكن الحديث عن تيار الإسلام السياسي دون التوقف عند شخصية مثل الدكتور حسن الترابي. برأيي، لم يكن الترابي مجرد قيادي حزبي، بل مفكر جريء حاول وسعى إلى استكشاف إمكانية تأسيس نموذج للدولة الحديثة يستند إلى مرجعية إسلامية شاملة.
حين تحالف الترابي مع الجيش ونفّذ انقلاب 1989، ظن كثيرون أن “دولة الإسلام” قد بدأت. لكن الواقع، كما أراه، أثبت أن الجمع بين الشريعة والسلطة المطلقة غالبًا ما يؤدي إلى فساد مضاعف. فباسم الدين، أُقصيت المعارضة، وتم تكميم الأفواه، وبرزت مظاهر المحسوبية والتمكين.
وهنا لا أرى أن المشكلة كانت في الشريعة نفسها أو في جوهر الدين، بل – كما أعتقد – في سوء التوظيف السياسي والمصلحي لتلك القيم. لقد تحوّلت الشريعة من منظومة أخلاقية إلى أداة ضبط سياسي.
وفي النهاية، انقلب البشير على الترابي، وتحوّلت الحركة الإسلامية إلى غطاء لحكم عسكري تقليدي استمر ثلاثين عامًا، وانتهى بثورة شعبية في 2019 أسقطت النظام بالكامل.
مصر: إخفاق اللحظة التاريخية [2]
في مصر، تحوّلت جماعة الإخوان المسلمين من أكبر قوة معارضة إلى أول تجربة حكم إسلامي بعد ثورة 25 يناير 2011.
من وجهة نظري، كانت تلك فرصة استثنائية، فقد منح التيار فرصة تاريخية للوصول إلى السلطة، إلا أن هذه الفرصة لم تُستثمر على النحو الذي يعزز الاستقرار السياسي ويؤسس لحكم ناجح.
لم يكن الإخوان مستعدين للحكم، لا سياسيًا ولا فكريًا. بدا واضحًا – برأيي – أن هناك ارتباكًا عميقًا بين خطابهم الدعوي القديم وحاجات العمل السياسي الواقعي. لم ينجحوا في بناء توافق وطني واسع، ولم يطوّروا خطابًا يستوعب اللحظة الثورية ولا يتصادم مع الدولة العميقة.
حكم محمد مرسي لم يكن مأساة في نتائجه فقط، بل في رمزيته أيضًا. لقد مثّل برأيي نموذجًا لفشل التيار الإسلامي في الانتقال من مربع التنظيم إلى مربع الدولة. وسرعان ما سقطت التجربة بانقلاب 2013، لتعود الجماعة إلى مربعها القديم: الاضطهاد دون مراجعة حقيقية.
تونس: التدرج بدل المواجهة [3]
في تونس، كانت الأمور مختلفة. من خلال تتبّعي لمسار حركة النهضة، أعتقد أنها قدمت نموذجًا أكثر وعيًا بالتعقيد السياسي والاجتماعي. لم تطرح النهضة نفسها كوصية على الدين، بل كفاعل سياسي له مرجعية إسلامية، وهذا فارق مهم جدًا.
زعيمها راشد الغنوشي، وهو مفكر بدوره، قاد تحولًا من الفكر الإخواني الكلاسيكي إلى ما يمكن تسميته بـ” الإسلام الديمقراطي التونسي”. لم تسعَ الحركة إلى السيطرة، بل خاضت تجربة المشاركة، وقبلت بدستور مدني، وتحالفت مع قوى سياسية مخالفة لها جذريًا.
بل أرى أن تنازلها الطوعي عن الحكم في 2014 حين احتدمت الأزمة السياسية، كان دليلًا على نضج استثنائي في بيئة عربية تعاني من فوبيا التنازل.
صحيح أن النهضة واجهت لاحقًا تحديات خطيرة، خاصة مع قرارات الرئيس قيس سعيد، لكن برأيي، بقيت التجربة التونسية متقدمة أخلاقيًا وسياسيًا عن غيرها.
المغرب: ترويض ناعم وسقوط انتخابي [4]
في المغرب، تختلف تجربة الإسلام السياسي عن مثيلاتها في بلدان المشرق، بحكم وجود نظام ملكي يضطلع بالدور المرجعي الأعلى في المجالات الدينية والدستورية.
حزب العدالة والتنمية، الذي خرج من عباءة الحركة الإسلامية، اختار منذ بدايته العمل داخل الإطار الملكي، وتبنى خطابًا معتدلًا، بل براغماتيًا إلى حد كبير.
بعد الربيع العربي، صعد الحزب إلى رئاسة الحكومة عبر انتخابات 2011، لكنه – برأيي – لم يُمارس السلطة كاملة، بل شارك في إدارة الملفات في سياق المشاركة السياسية التي تمت مراعاتها ضمن توازنات النظام الملكي.
ورغم حفاظه على موقعه لعقد كامل، إلا أن التنازلات المتتالية، والتماهي مع سياسات الدولة العميقة، أفقدته الكثير من رصيده الشعبي، خاصة بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل عام 2020، ورفع الدعم عن المحروقات.
في 2021، جاء السقوط المدوي: فقد الحزب معظم مقاعده في البرلمان، لا بسبب مؤامرة، بل كنتيجة طبيعية لفقدان الهوية والفعالية.
ومن خلال قراءتي، يمكن القول إن التجربة المغربية قدّمت نموذج “الترويض السياسي للإسلاميين”، حيث لم يُقصوا، لكنهم أُفرغوا من مضمونهم.
اليمن: الإسلام السياسي بين الدعوة والسلاح… والعداء المزدوج [5]
في اليمن، تأخذ تجربة الإسلام السياسي طابعًا شديد التعقيد، بسبب هشاشة الدولة، وتعدد مراكز القوى، وامتزاج الدين بالقبيلة والسلاح.
حزب الإصلاح – الذراع السياسية للإخوان في اليمن – سلك طريقًا متعرجًا بين منطق الجماعة ومنطق الدولة، وبين التمدد السياسي والتحالفات القبلية والدولية.
خلال التسعينيات، تحالف مع الرئيس علي عبد الله صالح، ثم دخل في خصومة معه. بعد ثورة 2011، كان الحزب لاعبًا أساسيًا، لكنه فشل في الحفاظ على التوازن بين الشارع والدولة، وفقد قدرته على إنتاج رؤية جامعة.
علاقته مع الحوثيين: من التعايش الحذر إلى العداء الكامل
- خاض الإصلاح مواجهات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، خاصة في صعدة وتعز ومأرب.
- اعتبر الحوثيون الحزب أداة سعودية وإخوانية، وخصمًا وجوديًا لا مجرد منافس سياسي.
- العلاقة بين الطرفين تحوّلت إلى حرب مذهبية وأمنية مفتوحة.
وفي الوقت نفسه، توترت علاقة الإصلاح مع التحالف العربي، خصوصًا الإمارات، التي دعمته في البداية ثم تحوّلت إلى دعم خصومه في الجنوب.
وهكذا، وجد الإصلاح نفسه محاصرًا بين حليف متردد وعدو عنيف، دون بوصلة وطنية واضحة، ما أدى إلى تآكله فكريًا وسياسيًا.
الأردن: إسلام سياسي تحت سقف النظام… ثم إلى الإقصاء [6]
تُعد تجربة الإسلام السياسي في الأردن نموذجًا فريدًا من حيث الاحتواء المنضبط. فقد سُمح لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل لعقود ضمن إطار قانوني، وشاركت في الانتخابات، وأدارت النقابات، واحتفظت بحضور اجتماعي وطلابي بارز، لكنها لم تُمنح أبدًا فرصة التمكين الحقيقي.
طوال سنوات، كانت الدولة الأردنية تُبقي الجماعة تحت سقف النظام، عبر آليات قانونية وسياسية تحدّ من تمددها، أبرزها تعديلات مستمرة في قوانين الانتخاب، ومناورات تحجيمية في المشهد العام. ومع ذلك، حافظت الجماعة على موقعها كأكبر قوة معارضة منظمة حتى منتصف العقد الماضي.
التحول الجذري وقع مؤخرًا، حين أعلنت الحكومة الأردنية تفكيك خلية أمنية مرتبطة ببعض المنتسبين إلى الجماعة، وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتخطيط لأعمال تمس الأمن الوطني. وعلى إثر ذلك، صدر قرار رسمي بحظر الجماعة وتصنيفها كتنظيم غير مرخّص، ما مثّل نهاية سياسية وقانونية لوجودها العلني.
ومع تصاعد القيود السياسية وتراجع الحضور المجتمعي للجماعة، لم يكن خروج الإسلاميين من المشهد الحزبي نتيجة قرار داخلي، بل جاء تتويجًا لمسار من التآكل السياسي والاجتماعي. فقد عجز التيار عن تطوير أدوات تواصله مع المجتمع، ولم ينجح في تقديم خطاب يستوعب التحولات الوطنية أو يتفاعل بفاعلية مع متطلبات الدولة. وفي هذا السياق، جاء القرار الحكومي بحظر الجماعة كإجراء قانوني حاسم، أنهى فعليًا الوجود السياسي العلني لأكبر تنظيم ذي مرجعية إسلامية في البلاد، مطويًا بذلك صفحة امتدت لعقود من المشاركة المشروطة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن:
هل يستسلم التنظيم لهذه النهاية؟ أم يعيد ترتيب صفوفه عبر واجهات قانونية أو اجتماعية جديدة؟
وإذا عاد، فهل يملك فكرًا سياسيًا متجددًا يتجاوز إطاره التقليدي، ويقدم بديلًا ديمقراطيًا يليق بتعقيدات الواقع الأردني المعاصر؟
أزمة المفهوم: بين الشريعة والدولة والديمقراطية [7]
من خلال تتبّعي للتجارب الست، يتبيّن لي أن تيار الإسلام السياسي لم يعانِ فقط من إشكاليات سياسية أو تحالفية، بل من أزمة فكرية بنيوية في تعريف ذاته ومشروعه السياسي. فقد ظلّ هذا التيار في كثير من الحالات يُقدّم الشريعة لا بوصفها مرجعية قيمية تضبط المجال العام، بل كـ” نظام شامل” يُفترض أن يُطبق على الفرد والدولة معًا، دون فصل واضح بين ما هو ديني وما هو مؤسسي.
لقد كان الموقف من الشريعة في الغالب صريحًا وواضحًا:
“الدين هو دين الفرد والدولة، معًا، والشريعة لا تُجزَّأ”.
لكن هذا الوضوح الخطابي لم يكن دوماً مصحوبًا بوضوح مفاهيمي أو مؤسساتي؛ فكيف تُطبَّق الشريعة في دولة مدنية حديثة؟ هل يُعاد إنتاجها بتأويلات معاصرة أم تُؤخذ كما هي؟ وهل الديمقراطية مقبولة بذاتها أم فقط كآلية للوصول إلى الحكم؟
لم تُحسم هذه الأسئلة حسمًا معرفيًا داخليًا، بل بقيت تُدار بالتأجيل أو الغموض أو الانقسام الداخلي.
وقد أضعف هذا الغموض من قدرة التيار على إنتاج خطاب جامع يستوعب التنوع، كما جعله في مواجهة مستمرة مع القوى المدنية التي رأت فيه مشروعًا إقصائيًا بلبوس ديني.
في المقابل، كانت بعض التجارب – مثل النهضة في تونس – أكثر وعيًا بأزمة المفهوم، وحاولت بناء فصل مرن بين الديني والسياسي، لكن تلك المحاولات بقيت محدودة التأثير على المشهد العام.
خلاصة مقارنة سداسية: من التمكين إلى الترويض إلى الإقصاء
عند النظر إلى تجارب الإسلام السياسي في السودان، مصر، تونس، المغرب، اليمن، والأردن، نجد مسارات متباينة، لكنها تلتقي جميعًا عند سؤال جوهري:
لماذا فشل هذا التيار في ترسيخ نفسه كفاعل وطني جامع، رغم شعبيته وتاريخه؟
- في السودان، تحوّل المشروع إلى سلطة قمعية دينية انتهت بثورة شعبية.
- في مصر، عجز عن التكيف مع الدولة والمجتمع، فسقط بانقلاب مدعوم شعبيًا.
- في تونس، قدّم نموذجًا ديمقراطيًا نسبيًا لكنه بقي مترددًا في حسم خياراته تجاه الحداثة، وفقد قوته تدريجيًا.
- في المغرب، تم ترويضه داخل النظام الملكي، ففقد هويته وسقط انتخابيًا.
- في اليمن، انقسم بين العمل الدعوي والمسلح، واصطدم بالحوثيين وتحالفات معقدة، ففقد بوصلته الوطنية.
- أما في الأردن، فقد عاش في مساحة منظمة لكن مضبوطة، ثم أُخرج من المشهد بعد قرار حكومي حاسم أنهى وجوده القانوني.
ما يجمع هذه التجارب أن الإسلام السياسي حين لم يُقصَ، تم احتواؤه، وحين حاول التمدد أو المواجهة، واجه ردودًا حاسمة من الدولة أو المجتمع. وفي جميع الحالات، فشل في بناء خطاب جامع يتجاوز منطق التنظيم إلى منطق الدولة.
وبرأيي، فإن الأزمة ليست في الإقصاء وحده، بل في أن الإسلاميين لم يُجروا مراجعة صادقة حين تراجعوا، بل انشغلوا باللوم والتبرير.
وهكذا، يدور التيار في نفس الدائرة: التمكين، فالخلاف، فالإقصاء، فالتبرير.
والسؤال الآن:
هل يستطيع الإسلام السياسي أن ينهض من جديد كمكوّن وطني ديمقراطي يتقبل التعدد، أم أنه سيظل رهين نزعة التنظيم والوصاية؟
توصيات
أولًا: توصيات لتيار الإسلام السياسي
- إعادة بناء الفكر السياسي على أساس وطني جامع، لا حزبي ضيق.
- الفصل بين الدعوي والسياسي، وعدم استخدام الدين كأداة للصراع أو التمكين.
- تبنّي الدولة المدنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
- مراجعة شاملة وصادقة للمسار، بما يشمل الاعتراف بالأخطاء والانفتاح على النقد.
- خطاب يحترم التعدد ويتخلى عن التخوين والتكفير المبطّن.
- تحالفات وطنية مفتوحة قائمة على القيم والمصلحة العامة لا الأيديولوجيا.
- الاستجابة لأسئلة الواقع وليس فقط الدفاع عن التراث أو الهوية.
ثانيًا: توصيات للسلطات السياسية
- استبدال الإقصاء الأمني بالإدماج السياسي المشروط بالدستور.
- الفصل بين الانتماء الفكري والحق في المواطنة.
- بناء دولة القانون والمؤسسات دون انتقائية.
- تشجيع التحول السلمي داخل تيارات الإسلام السياسي ومرافقة مراجعاتهم لا مواجهتهم.
- رفض توظيف ورقة الإسلام السياسي لتبرير الاستبداد أو التسويق الخارجي.
- تهيئة بيئة سياسية تشاركية تكبح التطرف وتعزز الانتماء الوطني الجامع.
خاتمة
تُظهر التجارب الست التي تناولناها أن تيار الإسلام السياسي في الوطن العربي، رغم تنوع ظروفه وسياقاته، قد واجه تحديات بنيوية تتجاوز حدود القمع والإقصاء. فالإشكال لم يكن دائمًا خارجيًا، بل كثيرًا ما كان نابعًا من الداخل: أزمة مفهومية لم تُحسم، وعجز عن بناء مشروع وطني جامع، وإخفاق في التفاعل مع متطلبات الدولة الحديثة والمجتمع المتغير.
لقد انتقل التيار في محطات عديدة من موقع الفاعل السياسي إلى موقع المتهم، ومن طموحات التمكين إلى واقع التراجع أو الإقصاء، دون أن يصحب ذلك مراجعة فكرية كافية أو تطوير عملي للخطاب والممارسة.
إن مستقبل هذا التيار لا يتوقف على تبدّل المواقف السياسية فحسب، بل على قدرته على التجديد العميق، والانخراط في الحياة الوطنية كمكوّن ديمقراطي مدني يتجاوز منطق الجماعة والوصاية، ويؤمن فعليًا بالتعددية، والمواطنة، والدولة الجامعة لا الغالبة.
وإلا فإن التكرار سيكون هو العنوان الدائم:
“دورة تبدأ بالوعد، تمر بالتوتر، وتنتهي بالإقصاء”
————————————-
المراجع
[1] حسن، أحمد. ماذا فعل الإسلام السياسي بالسودان؟ مركز مينا للأبحاث، 2025.
https://mena-studies.org/ar/الإسلام-السياسي-في-السودان/
٢ إندبندنت عربية. لماذا فشلت جماعات الإخوان المسلمين في الحكم؟، 2 يوليو 2021.
https://www.independentarabia.com/node/249461
٣ معهد كارنيغي للسلام الدولي. خروج النهضة المرتبك من الإسلام السياسي. 29 سبتمبر 2019.
https://carnegieendowment.org/research/2019/09/ennahdas-uneasy-exit-from-political-islam?
٤ الهاشمي، عمر. سقوط العدالة والتنمية والحاجة إلى فضيلة النقد الذاتي. الجزيرة نت، 11 أكتوبر 2021.
https://www.aljazeera.net/opinions/2021/10/11/سقوط-العدالة-والتنمية-والحاجة-إلى-فضيلة-النقد-الذاتي
٥ الجزيرة – حزب الإصلاح اليمني بعد 32 عاماً من التأسيس
aljazeera.net/opinions/2022/9/11/حزب-الإصلاح-اليمني-بعد-32-عاما-من
٦ المصري، علي. الدولة والإسلاميون في الأردن: المنعرج والفرصة. العربي الجديد، أبريل 2025.
https://www.alaraby.co.uk/opinion/الدولة-والإسلاميون-في-الأردن-المنعرَج-والفرصة
٧ الإسلام السياسي كفئة غير مكتملة ومتغيرة: مراجعة ما بعد التأصيل النظري” – عباس جونغ، رامي علي. مجلة Religions، المجلد 14، العدد 8، 2023، المقال رقم 980. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/8/980