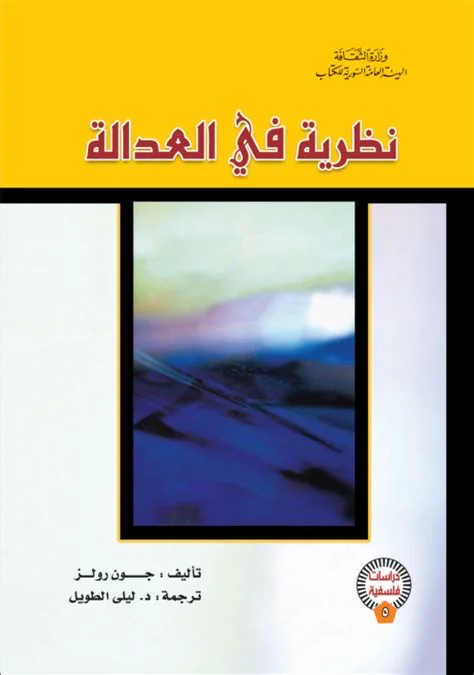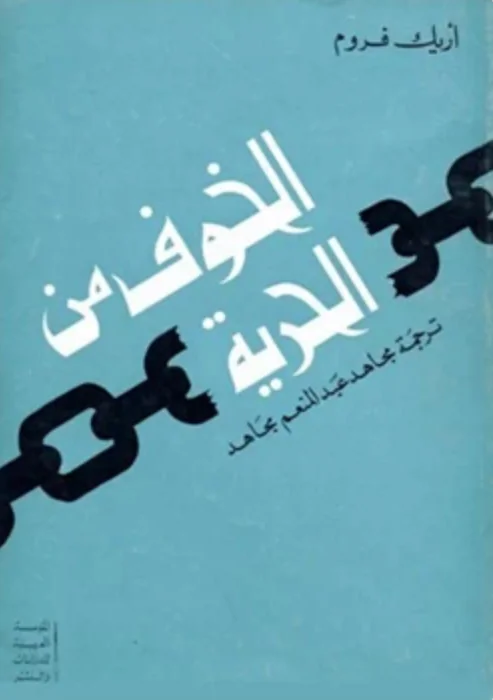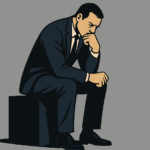
الحياد المعرفي ليس حيادًا أخلاقيًا
2025-05-25
مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة بعد موجة التطبيع الجديدة
2025-05-27بقلم: مركز المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
منذ صدوره عام 2012، أثار كتاب “Why Nations Fail” لعالمي الاقتصاد دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون، اهتمامًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية. فقد قدّم تفسيرًا جريئًا لفشل الدول ونجاحها، لا يقوم على الجغرافيا أو الثقافة أو الدين، بل على مدى شمولية أو إقصائية المؤسسات السياسية والاقتصادية في تلك الدول. وهي أطروحة بدت من الوهلة الأولى متماسكة، لكنها حين توضع في سياق العالم العربي، تثير تساؤلات أعمق.
يركز الكتاب على أن الدول التي تمتلك مؤسسات شاملة (inclusive institutions)، تشجع على الابتكار وتفتح المجال أمام التنافس العادل، وبالتالي تحقق الازدهار. بينما الدول التي تحكمها مؤسسات إقصائية (extractive institutions)، تركز السلطة والثروة في يد نخبة ضيقة، وتخنق الإبداع، وتقمع التغيير، مما يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في نهاية المطاف.
لكن ما يغفله المؤلفان – أو يتعاملان معه بسطحية – هو أثر التدخل الخارجي في رسم مصير هذه المؤسسات. فالكثير من الدول التي تعاني من فشل مؤسسي لم تُترك لتخوض تجربتها الداخلية بحرية، بل كانت ساحات لتجاذبات دولية، وانقلابات مدعومة، وتحالفات قسرية رسمت لها خريطة الطريق من الخارج. وفي هذا الإطار، تبدو بعض شعوب المنطقة كما لو أنها تُحاكَم على فشلها، بينما لم يُمنح لها أصلاً حق التجربة.
لنأخذ مثلًا الحالة المصرية: دولة ذات تاريخ طويل ومؤسسات بيروقراطية عريقة، لكنها عاشت طوال القرن العشرين تحت أنظمة شبه عسكرية أو سلطوية، احتكرت الحياة السياسية، وقمعت النقابات والمجتمع المدني، وأدارت الاقتصاد وفق منطق الريع والولاء. لم تكن الأزمة في غياب المؤسسات، بل في إفراغها من مضمونها. فهناك برلمان، وقضاء، وإعلام، لكن كل ذلك ظل شكليًا، مسيّجًا بقوانين الطوارئ وثقافة التبعية.
وعلى الجانب الآخر، نجد نماذج مثل تونس، التي حاولت – بعد الثورة – بناء مؤسسات شاملة، لكن المحاولة ظلت هشة لأسباب بنيوية داخلية، وضغوط إقليمية وخارجية، ونخبة سياسية لم تُحسن إدارة الانتقال الديمقراطي. هنا لا يمكن أن نحكم على “فشل” تونس بنفس مقياس دولة لم تحاول أصلاً أن تخرج من دائرة الاستبداد.
ما يحتاجه السياق العربي هو قراءة نقدية مزدوجة: نعم، هناك مسؤولية داخلية كبرى تتعلق بفساد النخب، وعسكرة السلطة، وتغوّل المصالح الخاصة. لكن هناك أيضًا بنية دولية ظالمة ساهمت في تقييد تحوّل هذه الدول، وحوّلتها إلى مناطق نفوذ، لا ساحات إصلاح. لا يمكن الحديث عن “مؤسسات إقصائية” دون فهم من أقصى من؟ ولماذا؟ وبأي أدوات؟
كما أن الكتاب يتعامل بقدر من التبسيط مع مفهوم “الثقافة” حين يُقصيها تمامًا من التحليل. لكن في المجتمعات العربية، تلعب الثقافة الدينية والتقليدية، إلى جانب الخطابات السياسية والإعلامية، دورًا محوريًا في تشكيل تصور الناس عن الدولة والمواطنة والشرعية. أي إصلاح مؤسسي لا يمر من هذه الثقافة، لا يمكن أن يصمد طويلًا.
في المحصلة، يمثل كتاب لماذا تفشل الأمم؟ مدخلًا مهمًا لفهم الديناميات المؤسسية للفقر والتنمية. لكنه ليس نصًا مقدسًا، بل رؤية جزئية يجب أن تُفكّك وتُوسّع من خلال عدسة الواقع العربي. واقع لا يخضع فقط لمعادلة الداخل، بل تُملي عليه قوانين الخارج، ومصالح القوى المتحكمة، التي كثيرًا ما ساهمت – بوعي أو دون وعي – في إنتاج هذا الفشل الذي نُسأل عنه وحدنا.