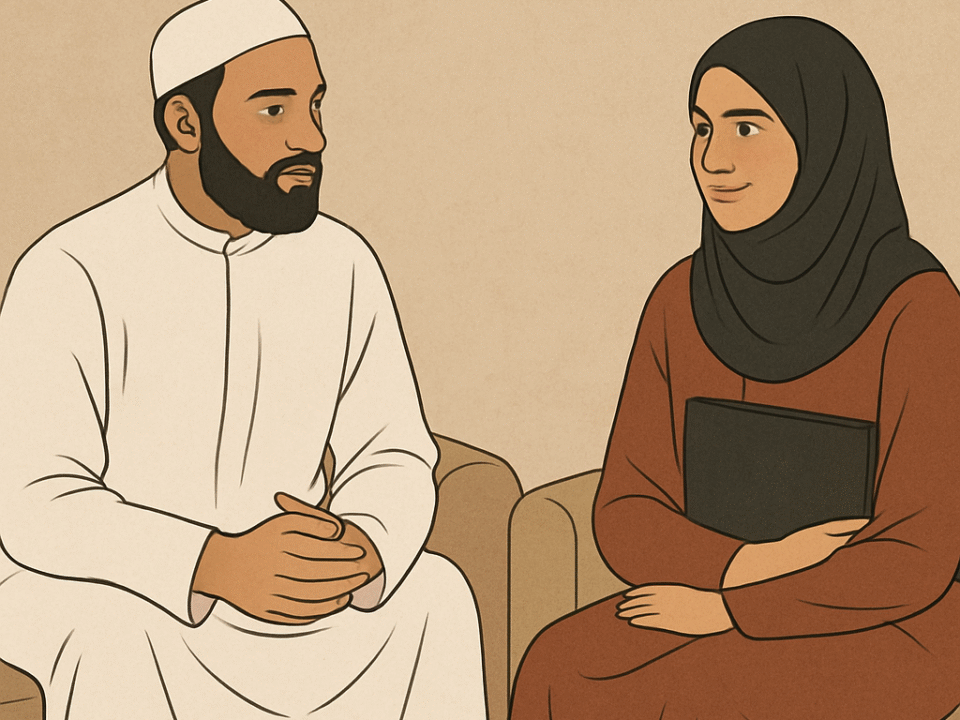هل يمكن إصلاح الدولة من داخلها؟ تأملات في جدوى الإصلاح التدريجي
2025-05-31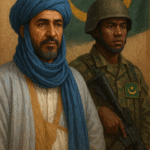
موريتانيا والتيارات الإسلامية: من إدارة التهديد الجهادي إلى ضبط تيار الإسلام السياسي
2025-06-01بقلم: منصة المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
مقدمة تحليلية: من إعادة الضبط إلى إعادة التوازن
في مقالها المنشور عبر تشاتام هاوس في مارس 2025، بعنوان “كيف يمكن للسعودية والولايات المتحدة إعادة ضبط الشرق الأوسط؟”[i]، قدّمت الباحثة د. لينا خطيب تصورًا طموحًا لمستقبل المنطقة، قائمًا على تراجع النفوذ الإيراني وصعود الدور السعودي بدعم من إدارة ترامب الجديدة. ترى الكاتبة أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية لتغيير موازين القوة في الشرق الأوسط، عبر شراكة استراتيجية تعيد تشكيل النظام الإقليمي لعقود قادمة.
ورغم أهمية المقال في رصد بعض التحولات الجارية بالفعل، إلا أنه – كغيره من القراءات النخبوية المتفائلة – يقع في فخّ تبسيط الديناميات الإقليمية المعقدة، ويُغفل العديد من الأسئلة الهيكلية الجوهرية:
- هل تراجع إيران هو نهاية حقيقية لمحورها؟ أم مجرّد إعادة تموضع مؤقت؟
- هل تمتلك السعودية القدرة، لا الرغبة فقط، لقيادة المنطقة وسط استقطاب حاد وتناقض داخلي؟
- وهل يملك المشروع الأمريكي الجديد رؤية متماسكة لما بعد الردع؟
- وماذا عن دور المجتمعات المحلية، والمطالب الشعبية، والفاعلين من خارج الدولة في صياغة الاستقرار؟
تهدف هذه المقالة إلى تقديم قراءة أكثر اتزانًا، تتجاوز سردية “إعادة الضبط” التي تروّج لها بعض النخب السياسية والفكرية، لتفحص بدلًا من ذلك ما إذا كان ما يحدث هو فعلاً إعادة إنتاج للنفوذ بأدوات جديدة، في نظام عربي لم يتحرر بعد من مأزق المحاور والتبعية الخارجية.
١. الانكفاء الإيراني: حقيقة أم تهويل استراتيجي؟
يشكل الحديث عن تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إحدى الركائز الأساسية في المقالات التي تبشّر بـ”نظام إقليمي جديد”، كما في طرح د. لينا خطيب. إذ تُقدَّم طهران – بعد اغتيال قاسم سليماني، وانهيار المحور في غزة ولبنان وسوريا – كقوة منهكة غير قادرة على استعادة زمام المبادرة. غير أن هذا التوصيف، رغم استناده إلى مؤشرات واقعية، يبقى جزئيًا وانتقائيًا.
الأدوات الإيرانية: من التمدد العسكري إلى التكيّف غير المعلن
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم تكن قوة إيران في التقدم العسكري الكلاسيكي، بل في شبكات النفوذ غير المتناظرة:
- وكلاء عابرون للحدود (حزب الله، الحشد، الحوثيون).
- أدوات ناعمة (إعلام، منظمات دينية، تغلغل اقتصادي رمادي).
- قدرة على تدوير الأزمات بدلًا من حلها، عبر الاستثمار في “الفراغات السيادية” لا المؤسسات الرسمية.
وبالرغم من أن الهجمات على إسرائيل في أكتوبر 2023 شكّلت تصعيدًا كاد أن يكون مكلفًا، إلا أن طهران لم تُستنزف فعليًا بالمعنى البنيوي، بل اكتفت – كما يبدو – بإعادة توزيع الضغط على حلفائها، وتخفيف الانخراط المباشر، في سياق أكثر تعقيدًا من مجرد “سقوط”.
فجوة التقدير الغربي: بين الضغط القصير والرؤية الطويلة
اعتمدت إدارة ترامب الأولى سياسة “الضغط الأقصى”، وتواصل الإدارة الثانية ذات النهج، لكن دون طرح بديل عملي يُلزم طهران بتغيير سلوكها دون التصعيد. فالانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وفرض العقوبات على شبكة النفط الإيراني، كلها أدوات ردع، لكنها لا تجيب عن سؤال ما بعد الردع.
إيران لا تزال لاعبًا في العراق ولبنان واليمن، ولو بتكتيكات أكثر مرونة. وهي تُجيد توظيف الأخطاء الأمريكية والخليجية لصالح سرديتها، خصوصًا حين يظهر الغرب كحليف لأطراف تتجاهل المطالب الشعبية.
2. الصعود السعودي: قيادة متوقعة أم طموح محفوف بالتحديات؟
في سردية “إعادة الضبط”، تُصوَّر السعودية بوصفها البديل العربي القادر على ملء الفراغ الذي خلّفه تراجع النفوذ الإيراني، وقيادة المنطقة نحو استقرار مدعوم من واشنطن. غير أن هذا التصور، رغم اتساقه مع طموحات الرياض في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، يتجاهل فجوة واسعة بين الطموح والإمكانات الفعلية.
◾ التحول السعودي: من الردع إلى الدبلوماسية الناعمة
منذ توقيع اتفاق بكين مع إيران عام 2023، تبنّت السعودية استراتيجية احتواء مرنة تقوم على:
- تقليل التصعيد المباشر مع الخصوم.
- تنشيط الدور الدبلوماسي في ملفات مثل لبنان وسوريا.
- التقدم المشروط نحو التطبيع مع إسرائيل مقابل إحياء مبادرة السلام العربية.
- لكن هذه الاستراتيجية لم تُختبر بعد في مسرح الأزمات المفتوحة. ففي اليمن، ما زال المسار السياسي هشًا؛ وفي لبنان، تتقاطع رغبة السعودية مع عراقيل بنيوية تتجاوز النفوذ الإيراني؛ أما في سوريا، فإن “زيارة ما بعد الأسد” تبقى رمزية أكثر منها مؤسسة لمسار سياسي متماسك.
◾ القيود الداخلية: استقرار فوقي أم بناء مؤسسي؟
لا يمكن تقييم الدور الإقليمي للسعودية دون التوقف عند التحولات الداخلية:
- رؤية 2030 قدّمت وعودًا تنموية طموحة، لكنها لا تزال تعتمد على قيادة مركزية، مع غياب الإصلاح السياسي التشاركي.
- الاستقرار الاقتصادي غير مضمون في ظل تقلبات أسعار النفط والضغوط الاجتماعية المتراكمة.
- الدور الأمني المهيمن على الحياة العامة قد يعزز السيطرة، لكنه يُقيد قدرة الدولة على بناء شبكات نفوذ مستدامة خارجيًا إذا لم تُرافقه إصلاحات مؤسسية عميقة.
◾ الشرعية الإقليمية: غياب الرؤية الجامعة
رغم أن السعودية تمثل تقليديًا مركز الثقل العربي، إلا أن العالم العربي لم يعُد كتلة واحدة يمكن قيادتها بـ”الإجماع الرمزي”. الانقسام بين المحاور (الدوحة–أنقرة من جهة، وأبوظبي–القاهرة من جهة ثانية)، وتباين أولويات دول مثل الجزائر والمغرب وتونس، يشير إلى أن الشرعية الإقليمية لم تعد محصورة في الرياض وحدها.
3. الدور الأمريكي: من استراتيجية الضغط إلى إدارة الاصطفافات
تطرح د. لينا خطيب في مقالها أن عودة إدارة ترامب تمثل لحظة مناسبة لتقارب أمريكي–سعودي يعيد ضبط الإقليم، لكن هذا الطرح يفترض ضمنيًا أن الولايات المتحدة تمتلك رؤية متماسكة وطويلة الأمد للشرق الأوسط. في الواقع، ما نشهده هو تحول واشنطن من موقع “صانعة للنظام” إلى موقع “مديرة للتحالفات المتقلبة”، ضمن بيئة دولية أكثر تشظيًا.
◾ من الانخراط إلى الانتقاء: ارتباك الدور الأمريكي
شهدت الاستراتيجيات الأمريكية تحولات لافتة:
- دارة أوباما ركّزت على “إعادة التوازن نحو آسيا” وتقليل التورط المباشر.
- إدارة ترامب الأولى (2016–2020) تبنّت سياسة الضغط الأقصى على إيران وراوحت بين العزلة والمساومة.
- إدارة بايدن حاولت استعادة الاتفاق النووي وتقليص التوترات.
- أما إدارة ترامب الثانية، فتميل إلى إعادة تثبيت التحالفات التقليدية، لكن دون مشروع سياسي متكامل.
هذا التقلّب المتكرر أفقد الولايات المتحدة جزءًا من مصداقيتها حتى لدى حلفائها، وفتح المجال أمام لاعبين مثل الصين وروسيا لتوسيع نفوذهم من خلال أدوات اقتصادية ودبلوماسية مرنة.
◾ واشنطن وإيران: احتواء دون مخرج
ترغب إدارة ترامب الحالية في تحجيم إيران دون السعي لتغيير النظام. لكنها، كما تُشير الكاتبة، تواجه تركة ثقيلة من السياسات المتناقضة:
- إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
- فرض عقوبات مالية واسعة.
- تجاهل الأطر التفاوضية متعددة الأطراف.
غير أن هذه السياسات، رغم شدتها، لا تنتج بديلاً بنيويًا لنفوذ طهران في الفراغات الإقليمية، خصوصًا في اليمن وسوريا والعراق. بل إنها قد تمنح طهران فرصًا جديدة لتقديم نفسها كضحية أمام جمهورها الداخلي وشبكاتها الدولية.
◾ التحالف مع السعودية: أداة نفوذ أم بديل عن الرؤية؟
الرهان الأمريكي على السعودية لا يُترجم تلقائيًا إلى استقرار. فبينما تستثمر الرياض نحو 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، تظل واشنطن بحاجة إلى ما هو أبعد من المال:
- مشروع سياسي شامل يعالج المعضلة الفلسطينية بجدية.
- انخراط فعّال في إعادة بناء الدول المتصدعة (سوريا، لبنان).
- إعادة تعريف “التحالفات الإقليمية” خارج منطق المحاور.
ما لم يحدث هذا، فإن التحالفات الصلبة قد تبقى أدوات تكتيكية، لا أدوات هندسة جيوسياسية طويلة المدى.
4. مأزق التطبيع والتهميش الفلسطيني: سلام بلا عدالة؟
في مقالة د. لينا خطيب، يُشار إلى أن السعودية قد تجعل من “إحياء مبادرة السلام العربية” شرطًا مسبقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورغم أهمية هذه الإشارة، فإن المقال يتعامل مع القضية الفلسطينية كـ”متغير تفاوضي” لا كمحدد بنيوي في مستقبل المنطقة. وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكالات في الخطاب السياسي المعاصر حول الشرق الأوسط: فصل التطبيع عن العدالة، وتصوير الاستقرار وكأنه ممكن دون حل جذري للقضية الفلسطينية.
من أوسلو إلى صفقة القرن… إلى تطبيع بلا سياق
منذ أوسلو (1993) وحتى ما يُعرف بـ” صفقة القرن”، انتقل العالم العربي – بتفاوت – من دعم المبادرة الفلسطينية إلى القبول الواقعي بإسرائيل كأمر واقع، دون أن يتحقق أي تقدم حقيقي في مسار الدولة الفلسطينية. ثم جاء التطبيع الإماراتي–البحريني في 2020 (اتفاقيات إبراهام) ليفتح الباب أمام “السلام من فوق”.
لكن السياق السعودي يختلف:
- مكانة الرياض الرمزية في العالم الإسلامي تجعلها محورًا حساسًا في ملف القدس.
- أي تقارب رسمي مع إسرائيل دون مكافأة سياسية حقيقية للفلسطينيين قد يفقد السعودية رصيدًا أخلاقيًا وشعبيًا.
- ومع ذلك، فإن التلويح بالتطبيع يبقى أداة ضغط تفاوضي تستخدمها الرياض لاختبار جدية إسرائيل والولايات المتحدة.
◾ غياب الفاعل الفلسطيني… تغييب متعمّد؟
يتعامل الخطاب الإقليمي مع الفلسطينيين كأنهم طرف غائب أو منقسم، بينما الحقيقة أن تغييبهم يتم بشكل متعمد من أغلب الأطراف الدولية والعربية، لأسباب تتصل:
- بضعف السلطة الفلسطينية وتآكل شرعيتها.
- وانقسام غزة–رام الله.
- وتفضيل بعض الدول العربية التعاطي مع الملف كملف “أمني” لا “وطني”.
لكن هذا التغييب – وإن خدم بعض الترتيبات المؤقتة – لا يُلغي جوهر الصراع. إذ لا يمكن تصور نظام إقليمي مستقر بينما تُهمَّش قضية تعتبرها الشعوب العربية مركزية، وتُبنى التحالفات على تجاوزها لا على حلها.
5. ما بين الشكل والجوهر: هل نحن أمام إعادة ضبط فعلًا؟
في العنوان الذي اختارته د. لينا خطيب لمقالها (كيف يمكن للسعودية والولايات المتحدة إعادة ضبط الشرق الأوسط؟), نجد استعارة تقنية تشير إلى إعادة “تهيئة النظام” بشكل منظم ومدروس. لكن الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط لا يُشبه لوحة تحكم قابلة للبرمجة، بل هو أقرب إلى نظام فوضوي متعدد القوى والمسارات، تحكمه صراعات مركبة، وفجوات سيادية، وتباينات داخل كل دولة، ناهيك عن بين الدول.
◾ من الضبط إلى إعادة إنتاج التوازنات القديمة
بعيدًا عن اللغة التفاؤلية، تشير كثير من المؤشرات إلى أن ما يحدث في المنطقة هو إعادة توزيع للأدوار ضمن النظام نفسه، لا ولادة لنظام جديد. فالسعودية تحلّ جزئيًا محل إيران في بعض الملفات، لكن بذات منطق التحالفات الصلبة والرهانات الجيوسياسية الضيقة.
- سوريا ما بعد الأسد لا تزال بلا عقد اجتماعي جديد.
- لبنان خرج من الشلل الرئاسي دون إصلاح بنيوي.
- العراق يُعيد تدوير أزماته تحت مسميات جديدة.
- غزة تنهار إنسانيًا رغم كل الطروحات الدبلوماسية.
كل هذا يشير إلى أن ما نراه ليس “إعادة ضبط” system reset، بل “إعادة تركيب” على أساسات مهترئة لم تُعالَج جذورها.
◾ الإسلام السياسي والجهاد العابر: الفاعل المُغيَّب في معادلة إعادة الضبط
رغم التأثير الكبير الذي مارسه تيار الإسلام السياسي، والتيارات الجهادية العابر للحدود في العقدين الأخيرين، تغيب هذه الفواعل عن تصورات إعادة الهيكلة الإقليمية، كما في سردية “إعادة الضبط” التي قدّمتها د. لينا خطيب.
في الوقت الراهن، تميل الأنظمة الفاعلة إلى تحييد الإسلام السياسي أو توظيفه في أدوار رمزية وخدماتية، دون منحه أي شراكة فعلية في ترتيبات ما بعد الصراع. ويعود ذلك إلى تراكم الشكوك حول موثوقيته السياسية، وتجارب حكمه التي ارتبطت بالاستقطاب وعدم الوضوح تجاه الدولة الوطنية.
أما التيارات الجهادية، فقد تراجع حضورها بفعل الضغوط الأمنية وتآكل شرعيتها المجتمعية، لكنها لا تزال قادرة على إعادة التموضع في البيئات الرخوة، وتستبطن سردية تعبئة لم تُهزم بالكامل بعد.
وأحد أبرز أوجه القصور في سردية “إعادة الضبط” هو افتراض أن الاستقرار يمكن هندسته من فوق، دون إعادة نظر في موقع هذه التيارات داخل المعادلة. فالإسلام السياسي لا يزال فاعلًا فكريًا وتنظيميًا في مجتمعات واسعة، حتى وإن تم تحجيمه سياسيًا؛ والجهاد العابر للحدود لا يزال يحتفظ بأدوات تعبئة في البيئات الرخوة.
وبالتالي، فإن تجاهل هذه التيارات لا يُنتج استقرارًا، بل يخلق فراغًا في المعنى، قد يُملأ مستقبلًا بردّات فعل أشد تطرفًا، أو ارتدادًا عن خيارات الإصلاح والانفتاح.
◾ ملامح مستقبل محتمل: التعدد بدلًا من القطبية
مع تضاؤل قدرة أي دولة منفردة – بما في ذلك السعودية – على احتكار قيادة الإقليم، تبرز الحاجة إلى نموذج توازنات مرن، لا قائم على المحاور، بل على التفاهمات المتعددة والمسارات المتداخلة.
- تعددية قطبية إقليمية تضم قوى من الخليج والمشرق، والمغرب العربي، وتركيا، وإيران.
- مساحات تفاوض غير محصورة في العواصم التقليدية.
- صعود المجتمع المدني كفاعل تدريجي في إدارة ما بعد الصراع.
هذا النموذج قد لا يكون جذّابًا لنخب السلطة، لكنه أقرب إلى الواقعية السياسية من أحلام “إعادة الضبط” التي تُقصي الديناميات الشعبية وتغفل هشاشة البناء الداخلي في أغلب دول المنطقة.
6. خاتمة وتوصيات: نحو استقرار لا يُصنع من فوق
إن سردية “إعادة ضبط الشرق الأوسط” كما طُرحت في مقال د. لينا خطيب، تعكس رغبة مشروعة لدى بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين في الخروج من منطق الفوضى المستدامة إلى حالة من الترتيب الاستراتيجي الجديد. لكنها – في جوهرها – تظل سردية نخبوية متمركزة حول توازنات القوى الرسمية، وتغفل عناصر ثلاثة لا غنى عنها لأي استقرار حقيقي: الشعوب، الهويات المتعددة، والمؤسسات القادرة.
لقد قدّمت المقالة تحليلًا متعدد الأبعاد لما اعتُبر “انكفاءً إيرانيًا” و“صعودًا سعوديًا”، وسلطت الضوء على أوجه القصور في المقاربة الأمريكية الجديدة، كما ناقشت مأزق التطبيع الذي يعزل المسألة الفلسطينية عن بنية النظام الإقليمي.
في ضوء هذا، لا يمكن الحديث عن “إعادة ضبط” دون الإجابة على أسئلة الجذور لا الأعراض، ودون إشراك الفاعلين المحليين والمجتمعيين لا الاقتصار على تفاهمات العواصم.
توصيات استراتيجية:
1. نحو مقاربة أمنية–تنموية–سياسية متكاملة
- أي مسار للاستقرار لا بد أن يدمج بين:
- ردع الفاعلين المسلحين غير الدولتيين،
- لكن أيضًا دعم عمليات المصالحة الوطنية،
- وبناء مؤسسات خدمية عادلة تُعيد الثقة بين المواطن والدولة.
2. إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كمحدد للنظام الإقليمي
- لا يمكن لأي تطبيع أن يُنتج استقرارًا إن كان قائمًا على تجاوز القضية لا معالجتها.
- إعادة إحياء مبادرة السلام العربية يجب أن ترتبط بجدول زمني واضح وتنازلات واقعية من جميع الأطراف.
3. تحييد الصراع السني–الشيعي من الخطاب السياسي
- الصراع بين السعودية وإيران يجب ألا يُؤطر طائفيًا.
- يمكن توسيع دائرة الحوار ليشمل ملفات بيئية، اقتصادية، وتنموية مشتركة بدلًا من الاقتصار على التوازنات الأمنية.
4. تعزيز الأطر متعددة الأطراف بدلًا من التحالفات المغلقة
- مستقبل الإقليم يتطلب توازنًا مرنًا بين عدة قوى (دول الخليج، مصر، تركيا، إيران، المغرب العربي).
- إنشاء آليات إقليمية مستقلة لفض النزاعات والوساطة.
5. توسيع دور المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميين
- لا استقرار بلا مشاركة سياسية أفقية.
- ·دعم المجتمع المدني والإعلام المستقل شرط لبناء وعي مجتمعي يُقاوم التطرف ويدعم التعددية.
الختام:
الشرق الأوسط اليوم لا يحتاج إلى “إعادة ضبط” كما تفعل الأنظمة الرقمية، بل إلى إعادة بوصلة تُوجّه الإرادات نحو أولويات الشعوب لا غرائز السلطة.
فلا المعادلات الأمنية تدوم، ولا الصفقات الكبرى تبني استقرارًا إن لم تتحوّل إلى مؤسسات عادلة، وحقوق مصانة، وأمل حقيقي يتجاوز رماد الوعود.
إن ما ينقص هذه المنطقة ليس اتفاقًا بين الحاكمين، بل عقدًا جديدًا مع المحكومين… يسترد فيه الإنسان مكانته، قبل أن تُهدرها حسابات المصالح من جديد.
————————————————-
[i] د. لينا خطيب، “كيف يمكن للسعودية والولايات المتحدة إعادة ضبط الشرق الأوسط؟”، نُشر في تشاتام هاوس – The World Today، بتاريخ 18 مارس 2025.
رابط المقال الأصلي:
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2025-03/how-saudi-arabia-and-us-might-reset-middle-east