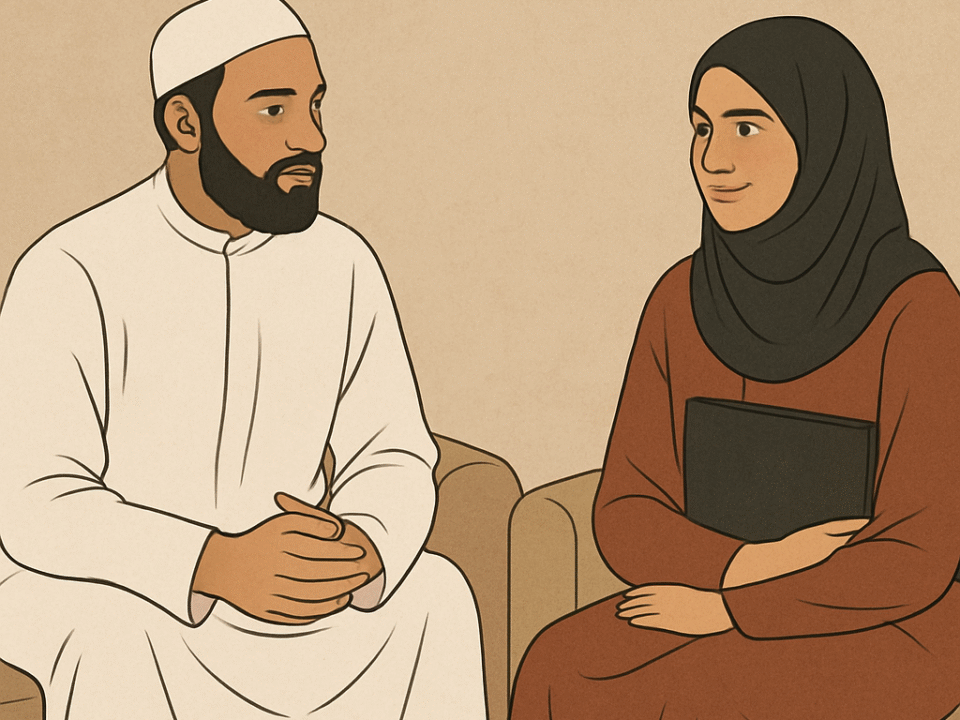بين الانكفاء الإيراني والطموح السعودي: هل تعيد واشنطن فعلاً ضبط الشرق الأوسط؟ (قراءة متوازنة في التحولات الجيوسياسية بعد 2023)
2025-06-01
الإسلام السياسي في الوطن العربي: من التمكين إلى التراجع – ست تجارب ونهاية واحدة؟
2025-06-08بقلم: منصة المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
“هذا المقال مقدّمة تحليليّة لدراسة موسعة تصدر قريبًا بنفس العنوان، وتتناول التجربة الموريتانية في التعامل مع التيارات الإسلامية، وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي، ضمن توازن حساس بين الاحتواء، الردع، والتفاعل مع الضغوط الإقليمية والدولية”.
مقدمة: تجربة بخصوصية نادرة
في محيط يعجّ بالفوضى المسلحة والقطيعة مع التيارات الإسلامية، خطّت موريتانيا لنفسها طريقًا مختلفًا. لا هي منحت تيار الإسلام السياسي مفاتيح التمكين، ولا واجهته بالعنف أو الاجتثاث. وبين هذا وذاك، استطاعت أن تُبقي الخطر الجهادي تحت السيطرة، دون أن تغلق الباب أمام التعددية السياسية.
لكن هذا “التوازن الصامت” لم يأتِ من فراغ. فقد استثمرت الدولة في شبكات العلماء، وحافظت على علاقة مرنة مع النخب التقليدية، مستفيدة أيضًا من تعاون غربي مكثّف في الملف الأمني، وتقاطعات إقليمية ساعدت – أو قيّدت – خياراتها أحيانًا.
خريطة التيارات: سياسي حذر، جهادي هش، وسلفي منعزل
في الداخل الموريتاني، يمكن تمييز ثلاثة أنماط من التيارات الإسلامية:
- تيار الإسلام السياسي ممثَّلًا بحزب “تواصل”، اختار طريق العمل القانوني والمشاركة البرلمانية، لكن بقي تحت مراقبة دائمة، وفي ظل تحفّظ داخلي وخارجي لم يُرفع تمامًا.
- التيار الجهادي، الذي حاول التمدد في العقد الأول من الألفية، لكنه اصطدم بحزم أمني، وغياب حاضنة مجتمعية حقيقية.
- التيار السلفي الدعوي، اكتفى بدور الوعظ، دون مشروع تغييري، مما أبقاه في الهامش الاجتماعي دون صدام أو تأثير سياسي.
بين أبو حفص والددو… حصانة من الداخل
تميّزت موريتانيا بإطلاق تجربة ناعمة في إعادة تأهيل بعض العائدين من الخطاب الجهادي. كان لرموز مثل أبو حفص الموريتاني دور مهم في مراجعات فكرية داخل السجون، فيما شكّل الشيخ محمد الحسن الددو جدار وقاية شرعي ومجتمعي ضد التطرّف، بخطاب يدمج بين الأصالة والواقعية.
التكامل بين من خاض التجربة الجهادية ثم راجعها، ومن امتلك شرعية دينية مجتمعية دون انخراط حزبي مباشر، وفّر للدولة أدوات تحصين فعّالة، بعيدة عن المقاربات الدعائية أو الأمنية الصرفة.
الأمن أولًا… لكن على حساب الحقوق أحيانًا
اعتمدت الدولة في البداية على الردع الأمني المكثف، بدعم غربي – فرنسي وأميركي خصوصًا – مكّنها من تطوير وحدات مكافحة الإرهاب، وتبادل معلومات استخباراتية، وتنفيذ حملات استباقية.
لكن هذا الخيار، رغم فاعليته، لم يكن متوازنًا دائمًا. فقد طُرحت تساؤلات داخلية حول بعض الاعتقالات، وإطالة أمد التوقيفات، وغياب الضمانات القضائية. كما أن بعض المقاربات الأمنية لم تتزامن مع إصلاحات حقوقية أو اقتصادية، ما يجعل جذور المشكلة كامنة في التربة، وإن خفتت نيرانها في العلن.
الإسلام السياسي تحت المجهر: احتواء محسوب واستقطاب إقليمي
لم يكن حزب “تواصل” بعيدًا عن الاستقطابات الإقليمية. ارتباطه المرجعي بجماعة الإخوان، وعلاقاته السابقة مع قطر وتركيا، جعله تحت أعين الدولة وبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين.
فمن جهة، استُخدم كأداة توازن داخلي، ومن جهة أخرى، خضع لضغوط غير معلنة، تضمنت التضييق على نشاطاته الخيرية، وتغييبًا ممنهجًا في الإعلام الوطني، وتحجيمًا لخطابه داخل النقاشات الكبرى.
في المقابل، فشل الحزب في فرض سرديته على الرأي العام، أو بناء تحالفات وطنية عابرة لهويته الفكرية، ما زاد من عزلته، رغم حضوره الانتخابي.
منصات الظل والتحليل الغربي: شيطنة بلا تمييز
من أخطر المؤثرات غير المباشرة على التجربة الموريتانية، كانت المنصات الاستخباراتية الغربية، التي رسّخت – في كثير من تقاريرها – صورةً ضبابية عن الإسلاميين في موريتانيا.
تقارير مثل تلك الصادرة عن Jamestown Foundation أو Soufan Center لم تميز بين تيار الإسلام السياسي، والجماعات الجهادية، بل قدّمت أحيانًا المؤسسات الدعوية أو المحاظر التقليدية كمجال محتمل لاختراق الفكر الراديكالي، ما انعكس على السياسات الأمنية، ودفع الدولة إلى تعزيز خطابها الوقائي، ولو على حساب بعض الحريات.
خاتمة: هل تملك موريتانيا خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد؟
نجحت موريتانيا، حتى الآن، في ضبط علاقتها بتيار الإسلام السياسي، واحتواء التهديد الجهادي، دون أن تنزلق إلى الفوضى أو القطيعة. لكنها لا تزال أمام مفترق دقيق:
- فالمقاربات الأمنية، رغم فاعليتها، لا يمكن أن تبقى بلا مظلة حقوقية ومؤسساتية.
- واحتواء الإسلاميين دون شراكة فعلية قد يُفضي إلى مزيد من العزلة أو المظلومية.
- أما السكوت عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فقد يُبقي الجذور التي يتغذى منها خطاب العنف نائمة، لكنها قابلة للعودة، لا سيما في ظل تصاعد “الجهاد العابر” وتبدّل أدوات التجنيد الرقمي.
إن المطلوب اليوم ليس فقط استمرار التوازن، بل الانتقال إلى صياغة عقد سياسي جديد، يعترف بالتعددية الدينية، ويُحصّن المجتمع بالفكر والتعليم، ويُشرك تيار الإسلام السياسي في مشروع وطني جامع، دون أن يُفرط بسيادة الدولة أو يفتح باب الاستقطاب.
فقد أثبتت التجربة الموريتانية أن “الإدارة الذكية للتديّن” ممكنة… لكن الذكاء وحده لا يكفي ما لم يُترجم إلى رؤية استراتيجية عادلة تمنع الانفجار القادم بصمت.