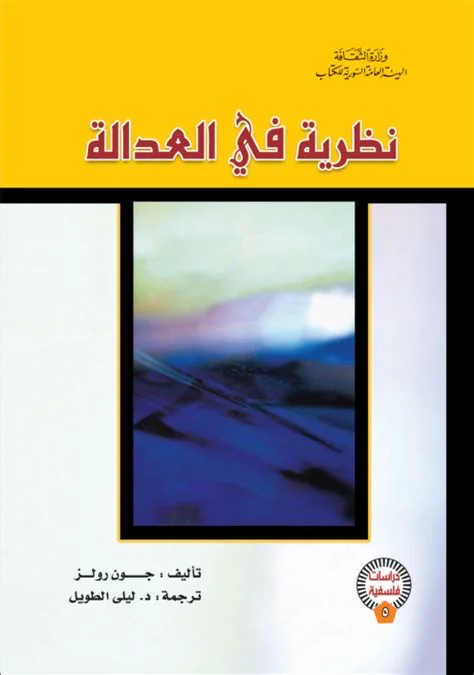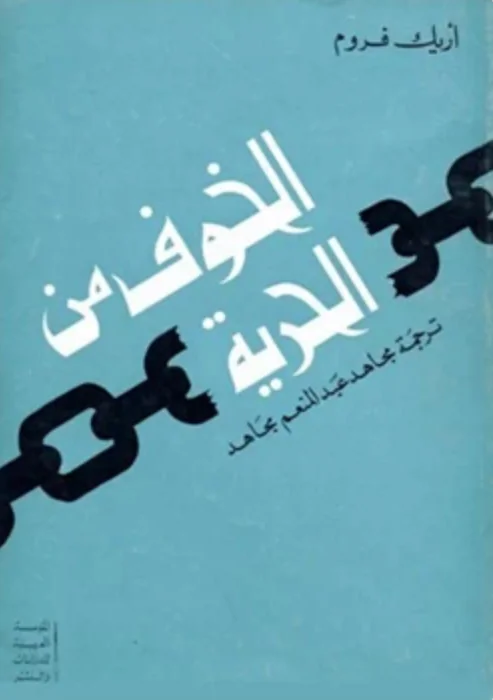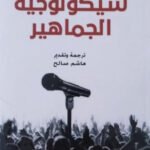
عصر الجماهير: قراءة تحليلية في سيكولوجيتها من منظور غوستاف لوبون
2025-06-09
المارد تحت القصف: هل تنهي الضربات الدور الوظيفي لإيران؟
2025-06-14مركز المدى للدراسات الفكرية والاستراتيجية
مقدمة تحليلية
يشكّل كتاب «المجاهدون في معارك فلسطين» [ii] للواء محمد طارق الإفريقي شهادة فريدة تخرج من قلب المعركة لا من هوامشها. فهي ليست مجرد مذكرات تقليدية لقائد عسكري، بل وثيقة ميدانية–سياسية تفضح، بهدوء وعسكرية منضبطة، كيف تركت الأنظمةُ العربيةُ الميدان الفلسطيني يواجه مصيره، مجرّدًا من الغطاء السياسي ومن الحدّ الأدنى من الإمداد والدعم.
فبين مشاهد المعارك، وتوثيق شجاعة المقاتلين، يتجلّى أن الهزيمة لم تكن عسكرية صرفة، بل كانت سياسية بالدرجة الأولى: تخبط في القرار، ارتباك في التنسيق، وانقسام في الرؤية، يقابلها تنظيم محكم من الطرف الصهيوني، ما أدى إلى سقوطٍ كُتب بدماء المجاهدين، ووثّقه الإفريقي بصدق القائد لا بروتوكول الرسميات.
فصل تمهيدي: سياق النشر… حين كُتبت الشهادة في عزّ الصمت
نُشر الكتاب عام 1951، في لحظة عربية مشبعة بالهزيمة والارتباك السياسي عقب نكبة فلسطين (1948). كانت الجراح لا تزال نازفة، ولم يكن قد تبلور خطاب نقدي ناضج يُراجع أسباب الانهيار. خيّمت على المنطقة حالة إنكار مشوبة بالخوف، وسط تصدّر روايات رسمية تُحمّل الفشل إمّا للخيانة أو لـ” ضعف الفلسطينيين”، مع تجاهل متعمد لمسؤولية الدول العربية.
في هذا المناخ، اختار اللواء محمد طارق الإفريقي أن يكتب. لا كمؤرخ رسمي، بل كمقاتل ميداني عاش التفاصيل وواجه الخذلان. جاءت مذكراته بقدرٍ من الجرأة المحسوبة، توجّه نقدها للمنظومة السياسية والعسكرية بلغة منضبطة، تُشير ولا تُفصح، وتدين من غير أن ترفع الصوت.
ملامح المرحلة السياسية والفكرية (1948–1951)
- كانت النخب تعيش صدمة استراتيجية، تبحث عن تبريرات لا عن مراجعات.
- غابت الجرأة عن انتقاد الجيوش والأنظمة، في ظل رقابة شديدة على الخطاب العام.
- ظهرت المذكرات الفردية، مثل كتاب الإفريقي، كمنافذ هامشية تقول بعض الحقيقة من داخل الميدان، خارج هيمنة الأجهزة.
مكانة الكتاب في ذاكرة ما بعد النكبة
- يُعد من أوائل الشهادات العربية الحيّة التي كتبها مقاتل غير فلسطيني، ما منحه طابعًا عابرًا للحدود.
- لم يحظَ بالانتشار الذي يستحق، ربما لأن نبرته اتسمت بالألم والمسؤولية، لا بلغة البطولات والتزييف التي فضّلتها أنظمة ما بعد الهزيمة.
من هو طارق الإفريقي؟
هو محمد بن عبد القادر الطرابلسي، الشهير بـطارق الإفريقي، وُلد عام 1886 وتوفي عام 1963.
ضابط ليبي – عثماني النشأة، تجاوز الحدود السياسية التقليدية في مسيرته العسكرية، فقاتل في ليبيا والحبشة، وساهم في تأسيس الجيش السعودي، حيث تولّى أول منصب رئيس لأركان الجيش السعودي، قبل أن يشارك في حرب فلسطين عام 1948، قائدًا لجبهات غزة والقدس.
ما يميز الإفريقي أنه لا ينتمي لأي تيار محلي أو فصيل سياسي، بل يمثل الضمير العربي الحر الذي حمل بندقيته دفاعًا عن فلسطين، ودوّن لاحقًا تجربته بشجاعة فكرية لا تقل عن شجاعته في الميدان.
بنية الكتاب: شهادات الحرب ونقد الدولة
يتخذ الكتاب شكل مذكّرات ميدانية مركّبة، تجمع بين الرواية الشخصية للواء محمد طارق الإفريقي وتحليل واقعي لمجريات الحرب. لا يقدّم المؤلف نفسه كبطل، بل كمُوثّق لمعركةٍ خيضت بإمكانات محدودة، وسط تخبّط سياسي وعسكري عربي.
طبيعة السرد
ينطلق السرد من أرض المعركة، حيث تتراكم التفاصيل: المواقع، التوقيت، طبيعة الاشتباكات، أسماء الشهداء، وحتى بعض الملاحظات اللوجستية. ورغم طغيان الجانب الميداني، إلا أن الإفريقي لا يغفل عن التوقّف عند العلل البنيوية التي شلّت الفعل العربي:
ارتباك القيادة، غياب الخطة، وتأخّر الإمدادات.
وظيفة الكتاب: بين التوثيق والنقد
الكتاب لا يتبنى خطابًا سياسيًا مباشرًا، لكنه يُضمّن نقدًا مبطّنًا للأنظمة العربية التي أرسلت جيوشًا بلا قرار، ومقاتلين بلا غطاء، ومعارك بلا استراتيجية. من خلال روايته، يتكشّف للقارئ حجم الهوّة بين تضحية المقاتلين وتردّد صناع القرار.
أبرز المحاور التحليلية في بنية الكتاب
1. تشخيص مواطن الفشل
يفكّك الإفريقي، عبر تجربته، العوامل التي ساهمت في خسارة المعركة:
· غياب التنسيق بين الجبهات، مما أدّى إلى تشتيت الجهود.
· نقص السلاح والذخائر، الذي لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة قرارات عليا.
· غياب قيادة موحدة، جعل من كل جبهة ساحة مستقلة بلا رابط.
· ارتباك القرار السياسي في العواصم العربية، وتضارب المصالح القُطرية.
2. رواية الجبهات
يوثّق المؤلف معارك عدة:
أسدود، بربرة، النبي داوود، سلوان، الفالوجة، المجدل… وغيرها.
لا يكتفي بوصف القتال، بل يُبيّن موقع كل معركة ضمن السياق العام للحرب، وعلاقتها بباقي الجبهات.
3. دور المجتمعات المحلية
يشير الإفريقي إلى دعم حقيقي وفعّال من المدنيين الفلسطينيين:
• تموين المجاهدين بالغذاء والماء.
• توفير ملاجئ للإيواء والإسعاف.
• المشاركة في المهام اللوجستية رغم ضعف الإمكانات.
هذا التلاحم الشعبي كان ـ في غياب الدولة ـ شبكة الأمان الوحيدة التي سندت المقاتلين، ويظهره الكاتب كعنصر مقاومة حقيقي مقابل الغياب الرسمي.
خلاصة التحليل البنيوي
الكتاب ليس مجرد مذكرات عسكرية؛ بل هو سجل تاريخي يقيم الحجة على أن الفشل لم يكن في صدور المجاهدين، بل في عجز الدولة، وتخاذل المنظومة العربية.
وفي كل صفحة، يتكرّر هذا السؤال دون أن يُصرَّح به:
“من الذي خذل فلسطين؟”
من السياسة إلى الجبهة: المجاهد والمجرد من السلاح
يتكرر في صفحات الكتاب مشهد المقاتل الذي ينتظر دعمًا لا يصل، ويُقاتل بسلاح فردي في وجه آلة صهيونية منظمة. هذا التكرار ليس عرضًا دراميًا، بل رمز لانفصال القرار السياسي العربي عن واقع الميدان.
يؤكد الإفريقي أن الحرب كانت قابلة للحسم لو أن هناك إرادة سياسية، وتخطيطًا موحدًا، وجرأة في اتخاذ القرار. لكنه وجد نفسه — كما وجد آلاف المقاتلين — في مواجهة عدو لا ينتظر، وحلفاء يتأخرون أو يتخلّون.
مذكرات أم مراجعة استراتيجية؟
رغم أن العمل كُتب على هيئة مذكرات، إلا أنه يطرح مراجعة استراتيجية دقيقة:
· تفكيك جغرافي للجبهات، مع توصيف تكتيكي مفصّل.
· تحليل لقدرات العدو من حيث التموضع والإمداد والهدف.
· رسائل غير مباشرة للإصلاح: حول الحاجة للتنظيم، والدعم الجوي، ووحدة القرار.
الكتاب يقدّم نفسه كأداة تقييم لمرحلة فارقة، وليس فقط كشهادة شخصية.
الفالوجة: رمز الكرامة رغم التخلي
يروي الإفريقي معركة الفالوجة كمثال فاضح على التناقض بين شجاعة المقاتلين وغياب القيادة السياسية. فالمجاهدون صمدوا شهورًا تحت الحصار، ولم يستسلموا رغم الانقطاع التام.
وتتحول الفالوجة هنا إلى رمز لعربٍ قادرين على القتال… لكنهم تركوا وحدهم، ليخوضوا معركتهم الأخيرة في ظل صمت العواصم.
الدولة تغيب والميدان يشتعل
لا يُخفي المؤلف امتعاضه من الأنظمة العربية، لكنه لا يتهم بشكل مباشر. بل يرسم صورة دقيقة لكيفية تعطيل السلاح، وغياب التنسيق، وحتى محاولاته الشخصية لشراء الذخائر من القاهرة عبر تبرعات فردية، وسط تخلي رسمي يكاد يكون متعمدًا.
ويبدو أن طارق الإفريقي — من موقعه كضابط محترف — كان يدرك أن الهزيمة السياسية غالبًا ما ترتدي لباسًا عسكريًا في أعين الناس، لكنه يصر على كشف الحقيقة: الهزيمة بدأت من القرار، لا من البندقية.
الذاكرة في مواجهة الرواية الرسمية
نُشر الكتاب عام 1951، في لحظة كانت الأنظمة العربية تصوغ روايات “بطولية” حول مشاركتها في الحرب. لكن الإفريقي قدّم رواية مضادة: بطولة الميدان لا تكفي، إن لم تسندها قيادة تعرف كيف ومتى وأين تقاتل.
الكتاب ليس نواحًا على الهزيمة، بل توثيق لما جرى قبل أن يُمسح من الذاكرة الجماعية أو يُعاد تأطيره في إعلام الأنظمة.
قراءة سياسية معمّقة
يوجه الإفريقي، دون تصريح، أسئلة حادة:
ولنتوسّع في هذا التحليل السياسي المعمّق الذي تفتحه الأسئلة غير المصرّح بها في خطاب طارق الإفريقي، لنقرأ ما بين السطور، وما وراء المواقف.
أولًا: من عطّل وصول السلاح؟
هذا السؤال يحيل مباشرة إلى المستوى الإقليمي والدولي من التواطؤ أو التخاذل. فمع أن معركة فلسطين عام 1948 كانت لحظة حاسمة، إلا أن شحّ السلاح وتقييد تدفقه إلى الجبهات يعكس وجود إرادة سياسية ما بعدم ترجيح كفّة العرب.
ربما لم يكن الخوف من “انتصار” عربي عسكري فقط، بل أيضًا من تصاعد روح تحررية عربية ترتبط بالمجاهدين لا بالحكومات الرسمية. وبالتالي، فإن تعطيل السلاح كان أداة لضبط الإيقاع السياسي للمعركة.
ثانيًا: غياب الجامعة العربية حين اشتعلت الحرب
الغياب هنا لا يعني فقط تقصيرًا مؤسسيًا، بل يكشف هشاشة الإرادة السياسية الجماعية للعرب. فالجامعة التي أُنشئت للتنسيق والتكامل، لم تستطع – أو لم تُرِد – أن تصوغ خطة عمل واضحة. كان القرار العربي متردّدًا، موسومًا بالانقسام والتنافس، لا سيما في ظل صراع الزعامات الإقليمية.
ما يطرحه الإفريقي ضمنيًا هو أن هذا الغياب لم يكن صدفة، بل كان نتاج بنية سياسية منهارة، أفرزت مؤسسات عاجزة عن اتخاذ القرار الحاسم في لحظات الوجود والمصير.
ثالثًا: بلا قيادة موحدة
غياب القيادة يعكس فقدان البوصلة الاستراتيجية.
كان المجاهدون في الميدان، لكن من في القيادة؟ تعددت الفصائل، تفرّقت الأوامر، وأصبح الميدان ساحة للصراع الداخلي على النفوذ، لا فقط على التحرير.
هذا يُبرز أن المعركة لم تُهزم فقط بالسلاح، بل بفوضى القرار السياسي والعسكري، وبتغليب الولاءات الجزئية على المصلحة العامة.
رابعًا: إطالة أمد المعركة دون قرار حاسم
كلما طالت الحرب، ازداد إنهاك القوى الشعبية، وازدادت فرص التفاوض بشروط المنتصرين سلفًا.
يوحي الإفريقي أن المعركة أُديرت بحيث تبقى في منطقة اللاقرار، لا يُسمح لها بالانتصار، ولا يُعلن عنها هزيمة واضحة، لتظل أداة ضغط ومساومة في لعبة توازنات أكبر من فلسطين.
هنا يظهر البعد الوظيفي للصراع، حيث لم يُترك للفلسطينيين ولا للمجاهدين حق حسم المعركة، بل ظلوا بيادق تُحرَّك بحسب مصالح العواصم.
الخلاصة:
صرخة مكتومة باسم الخذلان
حين يقول النص، ضمنيًا: “لقد خسرنا بسببكم، لا بسببنا”، فهو لا يلوم فقط الأنظمة ولا المؤسسات، بل يقدّم شهادة تاريخية دامغة على أن الهزيمة لم تكن عسكرية بقدر ما كانت سياسية.
هؤلاء الذين قاتلوا، فعلوا ما بوسعهم. لكن ما لم يُفعل – في الغرف المغلقة، وفي عواصم القرار – هو ما رجّح كفة النكبة
وفي خلفية كل هذه الأسئلة، تتكرّر مفردة الخذلان السياسي، وكأن الكتاب يصرخ بصوت خافت: “لقد خسرنا بسببكم، لا بسببنا”.
توصيات استراتيجية
1.إعادة تحقيق الكتاب علميًا، مع شروح عسكرية وتاريخية محدثة
يُوصى بإخضاع الكتاب لتحقيق علمي أكاديمي دقيق، يشمل توثيق الأسماء، وتحليل المواقع والجبهات، وربطها بالسياق العسكري والسياسي للمرحلة. كما يُستحسن إرفاقه بشروح نقدية حديثة تضيء على التفاصيل الغائبة، وتوضح الخلفيات الاستراتيجية للقرارات العسكرية التي وردت في النص، مما يحوّله إلى مصدر معتمد لدراسة حرب 1948 من منظور المقاتلين الميدانيين.
2.مقارنته بمذكرات ضباط عرب آخرين من الحرب ذاتها لرسم مشهد متكامل
من المفيد جمع وتحليل مذكرات قادة ومجاهدين من مختلف الدول العربية الذين شاركوا في حرب فلسطين، من مصر وسوريا والعراق وغيرها، بهدف تقديم رؤية مركّبة ومتعددة الزوايا. مثل هذه المقارنة تُسهم في الكشف عن التباينات في القيادة، وأوجه التنسيق أو غيابه، كما تُمكّن من فهم أعمق للفجوات البنيوية التي عرقلت العمل العربي المشترك.
3. تحويل الكتاب إلى عمل درامي توثيقي يُبرز التضحية مقابل التواطؤ أو التخاذل
يحمل الكتاب بُعدًا إنسانيًا وسياسيًا يصلح لأن يُجسّد بصريًا عبر فيلم وثائقي أو دراما تاريخية تتناول التجربة الشخصية لطارق الإفريقي في مقابل الخذلان السياسي العربي. عمل كهذا لا يوثّق فقط، بل يخلق وعيًا جماهيريًا جديدًا حول معارك ما زالت تروى من زاوية المنتصر أو المهزوم، دون الإنصاف للتجربة الميدانية المجردة التي عاشها هؤلاء المجاهدون.
4.تدريسه في كليات الدفاع والأمن القومي كمثال صارخ على الفجوة بين القرار والميدان
الكتاب يصلح ليكون مادة تحليلية وتدريبية في الكليات العسكرية وكليات الأمن القومي، حيث يُستخدم كنموذج لدراسة العلاقة المعقّدة بين السياسي والعسكري. يقدّم نموذجًا حيًا لحالة “القتال في ظل غياب القرار”، وهي حالة متكرّرة في النزاعات العربية، تُظهر خطورة غياب الإرادة السياسية الموحدة، ونتائجها الكارثية على الأداء الميداني والمعنويات
خاتمة
لم يكتب طارق الإفريقي ليتباهى، ولا ليستدرّ المجد من ذاكرة معركة منسية. لم يطلب عرفانًا، ولا رغب أن يُخلّد كبطلٍ على غلاف التاريخ.
بل كتب ليشهد.
شهادته ليست عن رصاصة أُطلقت، ولا عن جبهة صُدّت، بل عن خذلانٍ صامت، كان أشدّ وقعًا من العدو.
في سطور كتابه، تختلط المرارة بالشرف، وتنبثق الحقيقة القاسية:
“قاتلنا… لكن السياسة كانت ضدنا، لا معنا.”
هكذا لا يُدين الإفريقي الجندي، بل يُحاكم النظام. لا يلوم الهزيمة، بل يكشف من هندسها.
وما بين السطور، يتردّد صدى صامت:
“إننا لم نُهزم بالسلاح… بل بالتواطؤ، وبالوهن العربي الذي سبق المعركة وبقي بعدها”.
وها نحن اليوم نعود لقراءة هذا النص، لا لنندب الماضي، بل لنفهم أن التاريخ لا يُعيد نفسه… إلا حين تُكرر النخب أخطاءها، وتعيد الأنظمة إنتاج ذاتها، على حساب الدم والكرامة والحق.
المراجع:
[i] محمد طارق الإفريقي، المجاهدون في معارك فلسطين 1367هـ–1948م، دمشق: دار اليقظة العربية، 1951. النسخة الرقمية متاحة عبر:
https://archive.org/details/al.mujahdoun.fi.pal.
[ii] معارك فلسطين (1948):
تُشير إلى سلسلة المواجهات العسكرية التي اندلعت عقب انسحاب القوات البريطانية وإعلان قيام “دولة إسرائيل” في 15 مايو 1948، بين القوات الصهيونية من جهة، والجيوش العربية النظامية من مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان، إضافة إلى آلاف المجاهدين العرب. دارت المعارك على عدة جبهات مثل القدس، غزة، اللد، والرملة. وانتهت بنكسة عربية تُعرف بالنكبة، حيث فقد العرب نحو 78% من أرض فلسطين وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني. تُعزى الهزيمة إلى الخذلان السياسي والتنسيق العسكري الضعيف بين الدول العربية.
المصدر: من الانتداب إلى النكبة (1919–1948)، مركز الأبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية
رابط التحميل: https://2u.pw/4ZA7x